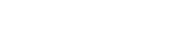Analyzing the carnival components in Mahmoud Darvish's poem "The Earth" based on
Subject Areas : Literary criticism
Mahin Hajizadeh
1
![]() ,
Abdolahad Gheibi
2
,
ali mohammadzadeh soltanahmadi
3
,
Abdolahad Gheibi
2
,
ali mohammadzadeh soltanahmadi
3
![]()
1 - faculty member of azarbaijan shahid madani university
2 - Vice Chancellor for Education and Culture, Shahid Madani University, University of Literature
3 - Arabic Secretary of Education of Urmia
Keywords: Carnival, dialogic logic, Al-Arḍ poem, Bakhtin, Mahmoud Darwish.,
Abstract :
The poem Al-Arḍ by Mahmoud Darwish is the product of the bitter experience of exile, alienation, and cultural resistance, in which poetic language transforms into a space for articulating both personal and collective memories. Darwish creates a carnivalesque atmosphere through the use of metaphorica, and at times colloquial language, where boundaries between reality and imagination, presence and absence, life and death are blurred. The characters in the poem, often without clearly defined identities, engage in continuous dialogue with nature, soil, and memory, forming a linguistic and visual celebration of resistance. Considering its socio-political context, this poem contains carnivalesque elements such as grotesquerie, street and marketplace language, critique of power, and the blending of contradictory emotions. The aim of this study is to explain some of these components in the poem using an analytical-descriptive approach based on Mikhail Bakhtin’s theory, in order to demonstrate how these elements contribute to the representation of the polyphonic space within the work. Research findings indicate that Al-Arḍ is an example of the emergence of carnivalization in contemporary poetry, where the poet, by rejecting monologism and creating a multi-layered discursive space, constructs a carnivalesque structure. This structure not only disrupts official norms but also provides a means for representing complex realities within Palestinian society. it shows that Darwish's poetry is not merely a vehicle for political or emotional messages, but rather a space in which popular culture, vernacular language, and carnivalesque patterns reflect a creative form of resistance against oppressive power.
احمدی، بابک. (1375). ساختار و تأویل متن، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز
باختین، میخائیل. (1387). تخیّل مکالمه ای ، ترجمه رویا پورآذر، تهران: نشرنی.
باختین، میخائیل(۱۳۷۲).دوبلین فرنیستر: فلسفه زبان شناسی. ترجمهٔ محمدعلی اسلامی ندوشن، تهران: نشر فرهنگستان.
باختین، میخائیل(۱۳۸۲). فرهنگ عامه در روسیه دیرباز: نمایشها، جشنها، زبان شفاهی. ترجمهٔ حسن انوشه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
بلیک و دراسیدل، جرالد اچ و آلاسدیر. (۱۳۶۹) . جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه میر حیدر مهاجرانی، چاپ اول، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
تامسن، فیلیپ. (1390). گروتسک، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز.
درویش، محمود. (2000). الأعمال الشعریة الکامِلة، الطبعة الثانیة، بغداد دارالحریة للطباعة و النشر.
الدسوقی، عمر. (2003). فی الادب الحدیث، بیروت دارالفکر.
سلیمان، خالدا. (1376). فلسطین در شعر معاصر عرب، ترجمه شهره باقری- دکتر عبدالحسین فرزاد، چاپ اول، تهران: نشر چشمه.
عطیه، بشیر عبد زید. (2009). «أشهر السنة ودلالتها فی الشعر العراقی الحدیث، مجلة القادسیة فی الآداب والعلوم التربویة»، المجلد8. العدد3.
غلامحسین زاده، غریب رضا و غلامپور، نگار. (1387). میخائیل باختین: زندگی، اندیشه ها و مفاهیم بنیادین، تهران: نشر روزگار.
کادن، جی آی. (1380). فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.
ملاابراهیمی، عزت و رحیمی، صغری. (1396). «تحلیل مؤلفه های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا»، مجله زبان و ادبیات عربی، شماره 16، صص 275-306.
نظری، راضیه و نجفی ایوکی، علی. (1398). «نشانه شناسی سروده قصیده الارض محمود درویش با تکیه بر نظریه نشانه شناسی گریماس»، فصلنامه پژوهش های ادبی بلاغی، سال هفتم، شماره 26، ص 68.
نولز. (1940). شکسپیر و کارناول پس از باختین، ترجمه رویا پورآذر، تهران: انتشارات هرمس، چاپ اول
قراءة في المؤشرات الكرنفالية في قصيدة "الأرض" لمحمود درويش على ضوء نظرية باختين
مهین حاجي زاده (الكاتبة المسؤولة)
أستاذة في قسم اللّغة العربیّة وآدابها بجامعة الشّهید مدني بأذربیجان، إیران
عبدالأحد غیبي
أستاذ في قسم اللّغة العربیّة وآدابها بجامعة الشّهید مدني بأذربیجان، إیران
علی محمدزاده سلطان أحمدي
طالب الدکتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها، بجامعة الشّهید مدني بأذربیجان، إیران
تاريخ الاستلام: 25/12/1446ق تاريخ القبول: 29/01/1447ق
الملخص
قصيدة الأرض للكاتب محمود درويش هي نتيجة تجربة مريرة من المنفى والغربة والمقاومة الثقافية، حيث يتحول لغة الشعر إلى فضاء لعرض الذكريات الفردية والجماعية. يخلق درويش بفضل استخدامه لغة رمزية وعاطفية وأحياناً عامية، جوا ًكرنفاليًا حيث تتلاشى الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال، وبين الحضور والغياب، وبين الحياة والموت. الشخصيات الشعرية، التي تكون في الغالب بلاهوية واضحة، تخوض حواراً مستمراً مع الطبيعة والتربة والذكريات، لتجسد نوعاً من الاحتفال اللساني والصوري للمقاومة. تحمل هذه القصيدة من منظور الخلفيات الاجتماعية والسياسية المعاصرة، مكونات كرنفالية مثل الغروتسك، ولغة الشارع والسوق، والنقد اللاذع للسلطة، وامتزاج المشاعر المتضاربة؛ إذن يهدف البحث الحالي إلى توضيح هذه المكونات في القصيدة المذكورة باستخدام منهج تحليلي-وصفي والاعتماد على نظرية باختين، وذلك بهدف إظهار كيفية مساهمة هذه العناصر في تمثيل الفضاء متعدد الأصوات في العمل. ونتائج البحث تشير إلى أن قصيدة الأرض تمثل مثالاً على ظهور الكارنفالية في الشعر الحديث، حيث يخلق الشاعر من خلال نفيه للأحادية وإنشائه لفضاء خطابي متعدد الطبقات، بنية كرنفالية تقوم في الوقت نفسه بخرق المألوف والقواعد الرسمية، وتتيح إمكانية تمثيل التعقيدات الواقعية في المجتمع الفلسطيني. كما تظهر أيضا أن الشعر عند درويش ليس مجرد حامل لرسالة سياسية أو عاطفية، بل هو فضاء يعكس فيه ثقافة الشعب ولغته العامية والنماذج الكارنفالية نوعاً من المقاومة الإبداعية أمام السلطة المهيمنة.
الكلمات الدليلية: الكارنفال، المنطق الحواري، باختين، محمود درويش، قصيدة الأرض.
المقدمة
ميخائيل باختين يعتبر المفهوم الكارنفالي كعملية ثقافية-اجتماعية يتم فيها أحداث تغييرات في البنيان الرسمي واللغات السائدة بفضل حضور لغات متنوعة وخطابات متضاربة. هذه الظاهرة، وخلافا للمناهج الأحادية، تؤكد على التنوع اللغوي والتعددية الصوتية وتوفير جو حواري حر وديناميكي بفضل الاستعانة بعناصر الهزل والسخرية والالتواء، مما يتيح إمكانية النقد وإعادة التفكير في العلاقات السياسية والمعايير الاجتماعية.
وتؤدي الكارنفالية في الأعمال الأدبية، وخاصة في تلك التي تتناول تمثيل التناقضات الاجتماعية والسياسية، دورا كأداة لكشف التناقضات وإعادة تعريف الهويات الثقافية، حيث تسهم في خلق فضاء حيوي ومتشعب من خلال كسر الحدود الرسمية بين اللغة والمعنى. تعتبر قصيدة الأرض لمحمود درويش، في إطارها التاريخي والسياسي الفلسطيني، مثالاً على تجلي العناصر الكارنفالية في الشعر العربي الحديث. هذه القصيدة، بفضل استخدامها لغة السوق والشارع و الغروتسك، وللتناقض في القيم، وللحضور المفاهيمي المتضاد، تخلق بناء شعريا ًمتعدد الطبقات والمعاني لا يكتفي فقط برواية الألم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بل تنفي أيضا هيمنة الخطابات الرسمية وتعرض فضاء خطابيا متعدد الأصوات.
وتمكن هذه الخصائص درويش من نقل تجربة الشعب الفلسطيني الواقعية ومقاومته الجماعية إلى المتلقي بشكل ملموس ونقدي بفضل اللجوء إلى اللغة العامية والصور الغريبة. وبالتالي فإن الفهم الدقيق لهذه العناصر يمكن أن يسهم في فهم أفضل لكيفية تمثيل التعقيدات السياسية والاجتماعية والنفسية في الشعر المقاوم. ومن جهة أخرى، وبما أن للخلفيات التاريخية والاجتماعية تأثيرا عميقا على البنيان اللغوية والمفاهيمية في شعر درويش، فإن التحليل الكارنفالي يمكن أن يوفر إطارا نظريا لإعادة قراءة هذه الأعمال، وهو ما يساعد على فهم العلاقة بين اللغة والسلطة والمجتمع في النصوص الأدبية الحديثة.
الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تحليل وشرح المكونات الكارنفالية في قصيدة الأرض استنادا إلى آراء ميخائيل باختين. تحاول هذه الدراسة إظهار كيفية استخدام العناصر الكارنفالية الرئيسية مثل الغروتسك واللغة المحكية والتناقض في القيم والتعددية الصوتية داخل البنية الشعرية لدرويش لخلق فضاء نقدي ومعقد يوفر في الوقت نفسه، امكانية تمثيل التعقيدات السياسية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني مع رفض الهيمنة الأحادية.
أسئلة البحث
1- كيف تمثل العناصر الكارنفالية في البنية الشعرية لقصيدة الأرض لمحمود درويش؟ وما الدور الذي تلعبه هذه العناصر في خلق فضاء متعدد الأصوات وفي النقد الاجتماعي والسياسي؟
2- كيف يدل استخدام العناصر الغريبة (الغروتسك) والتناقض في القيم ولغة السوق والشارع في قصيدة الأرض على العمليات الكارنفالية وعلى التفاعل بين اللغة والسلطة وهوية الثقافة الفلسطينية في الشعر المقاوم؟
خلفیة البحث
أجريت العديد من الدراسات القيمة فيما يتعلق بالمنطق الحواري والفضاء الكارنفالي؛ إلا أنه وبعد إجراء التحريات اللازمة لم يعثر على أي بحث تناول شعر محمود درويش بالاعتماد على النظرية الكارنفالية. ومن بين الدراسات ذات العلاقة الجزئي بموضوع هذه المقالة نذكر ما يلي:
علي رضا نظري وآخرون في مقالهم الموسوم بـ « کارکرد گفتگو در اشعار مقاومت محمود درویش بر مبنای نظریه گفتگومندی باختین؛ مورد پژوهش شعر جندي یحلم بالزنابق البیضاء » (1400ش) حاولوا استخدام نظرية الباختین الحوارية لتحليل الحوارات الموجودة في القصيدة «جندي يحلم بالزنابق البيضاء» لهدف تبيان الأصوات المختلفة التي تعكسها درويش في القصيدة والإشارة إلى دور هذا العنصر في تركيب النص الشعري.
كما أن هناك المقال الموسوم بـ « تحلیل کاربرد شناختی قصیده الأرض محمود درویش با تکیه بر نظریه کنش گفتار » (1399ش) الذي قام فيه هادي علیبور وآخرون بتحليل قصيدة الأرض باعتبارها عملا لغويا ضمن إطار نظرية الفعل اللغوي، وذلك بهدف الوصول إلى قراءة تطبيقية للنص باعتباره عملا لغويا ينسجم مع أعمال المقاومة الأخرى. واعتمادا على نموذج فعل الكلام لجون سيرل، أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر الوظائف شيوعا في القصيدة هي الوظيفة الإخبارية والعاطفية.
و مقالة زهرا فرید تحت عنوان «مولفههای کارناوال در رمان سیدات القمر جوخه الحارثی بر اساس نظریه باختین» (1402ش) تتناول تحليل عناصر الكرنفال في رواية سیدات القمر وتوصلت إلى أن عوامل مثل خلق شخصيات متعددة من طبقات مختلفة، بالإضافة إلى استخدام عناصر الصورة الغروتيسكية مثل المبالغة وكسر الأعراف الاجتماعية ودمج الموت والحياة، أدت إلى تمتع الأفكار المختلفة بمساحة حوارية بصوت متساوٍ وخارج عن سيطرة الكاتب.
المباحث النظرية
في هذا الجزء سنتناول معنى الكرنفال ومكانة باختين فيه وطبيعة قصيدة الأرض وسبب نظم الشاعر لها:
باختين والكرنفال
نظرية الكرنفال عند ميخائيل باختين، عالم اللسانيات والنقد الأدبي الروسي، تعد واحدة من أهم المناهج في تحليل الثقافة الشعبية واللغة الشفوية. يقدم باختين في أعماله مفهوم الكرنفال كنظام ثقافي اجتماعي تنقلب فيه التسلسلات الهرمية الاعتيادية للمجتمع، ويتاح فيه مجال للسخرية والتهكم في مواجهة السلطات الرسمية. (باختين، ١٣٧٢ش: ٢٥٠–٢٦٠) يطلق باختين على هذا الفضاء المؤقت وغير الرسمي اسم الكرنفال، حيث يتحرر الناس من الأقنعة والمعايير اليومية، ويتمكنون من تقديم نقد لهجي وغير مباشر لأنظمة السلطة.
وفقًا لرؤية باختين، فإن الكرنفال ليس مجرد احتفال، بل هو رؤية للعالم تمكن الفرد، ككائن اجتماعي، من التفاعل مع جميع هياكل السلطة والمؤسسات بشكل مؤقت وخارج عن المألوف. (باختين، ١٣٨٢ش: ١٢٥) في هذا الفضاء، تلعب اللغة الشعبية، والسخرية، والهجاء، والمحاكاة الساخرة، والحوار متعدد الأصوات (polyphony) دورًا محوريًا. يضع باختين اللغة الكرنفالية في مقابل اللغة الرسمية المهيمنة، ويرى فيها فضاءً للتعبير عن الحرية ومواجهة الأنظمة الأيديولوجية.
كان الكرنفال بأكمله نظامه الصوري المعقد، الشكل الأكمل أو بتعبير آخر الشكل الأصيل لظهور الثقافة الشعبية؛ كان الحياة التي تتشكل في إطار اللعب. ويضيف باختين: الكرنفال، على عكس الاحتفالات الرسمية، كان يعتبر انتصارًا (ولو مؤقتًا) للحقيقة على الأنظمة القائمة، نوعًا من الإلغاء المؤقت للعلاقات الهرمية والامتيازات والقوانين والمحرمات. كانت لغة هذه الاحتفالات الشعبية وقحة وصريحة، لغة محررة من كل ما كان ممنوعًا سابقًا، وخالية من كل القواعد المفروضة؛ لغة شعبية حية تقاوم هيمنة اللغة اللاتينية وتسخر من بعض عناصرها. (أحمدي، ١٣٧٥ش: ١٠٧)
في النهاية، يعتقد باختين أن تأثيرات الكرنفال واضحة في النصوص الأدبية أيضًا، خاصة في الأعمال التي تتميز باللغة الشفوية، والشخصيات من الطبقات الدنيا، والموضوعات الهجائية. فقد تأثر كتاب مثل رابليه وسرفانتس بثقافة الكرنفال، واستخدموا المحاكاة الساخرة والتقليد الفني لتسليط الضوء على هياكل اللغة والثقافة الرسمية. (باختين، ١٣٧٢ش: ٢٧٠) هذا المنظور الباختيني يستخدم كأداة تحليلية قوية في الدراسات الثقافية والأدبية وحتى الإعلامية.
قصيدة الأرض
قصيدة الأرض هي إحدى قصائد الديوان الشعري أعراس، ويجب البحث عن سبب نظم هذه القصيدة في أحداث سبعينيات القرن العشرين. ففي عام 1976 عقد نظام الاحتلال الصهيوني وقادة بعض الدول العربية اجتماعا وافقوا خلاله على ما يسمى بمشروع تطوير منطقة الجليل، لكن الهدف الحقيقي كان تحقيق التهويد في منطقة الجليل. إعلان هذا الخبر رسميا أثار احتجاجات شعبية واسعة النطاق. في المقابل قمع المحتلون هذه الاحتجاجات بقوة، حتى تحولت جميع الممرات إلى ساحات لقتل المتظاهرين. أطلق على هذا اليوم في التقويم السياسي الفلسطيني اسم يوم الأرض. وقد عكس محمود درويش في قصيدته الأرض هذا الحدث التاريخي الأليم بإتقان فني. (نظري ونجفي، 1398ش: 68)
عناصر الكرنفال في قصيدة الأرض
قصيدة الأرض لمحمود درويش هي من أبرز أعماله في مجال الكرنفالية والحوارية. ومن أجل فهم أكثر موضوعية لتقنياتها التعددية، من الضروري تحليل النماذج المتطابقة لها في إطار عناصر الكرنفالية التي تشمل استخدام اللغة الرمزية وغير المباشرة، والنقد الاجتماعي المصحوب بالسخرية والسخرية الفلسفية، وتعزيز الفضاء متعدد الأصوات، والواقعية الغروتيسكية، وتحدي قيم الخطاب المهيمن، إلى جانب العناصر الفرعية التي تتضمن تحليل قيم الخطاب السائد على ثلاثة مستويات: الاجتماعي الثقافي، والسياسي، والأدبي.
استخدام اللغة الرمزية وغير المباشرة
شهد عهد حكم جوزيف ستالين أحد أحلك الفترات في تاريخ الاتحاد السوفيتي، حيث أصبحت الرقابة المشددة والتطهير السياسي وإسكات الأصوات المعارضة سياسة رسمية. في مثل هذا الجو، اضطر الكتاب والمثقفون إلى اللجوء للغة رمزية ومواربة وسرد غير مباشر للتعبير عن أفكارهم. عاش ميخائيل باختين جزءاً من هذه الفترة وكتب بعض أهم أعماله في ظل ظروف كان أي نقد صريح قد يؤدي إلى الإقصاء أو الإعدام.
في فلسطين أيضاً، وبسبب القمع والضغوط السياسية والثقافية والأدبية المكثفة، اضطر شعراء الداخل الفلسطيني (الأراضي المحتلة) بدءاً من ستينيات القرن الماضي، نظراً للطبيعة الأحادية للنظام الإسرائيلي المحتل الذي أدى إلى انهيار نظام الحوار وتعددية الأصوات، إلى تجنب التعبير المباشر واللجوء إلى الرمز والأسطورة. يعتبر محمود درويش الممثل الأبرز للشعر الرمزي في أدب المقاومة؛ فهو من الشعراء الذين عبّروا عن المفاهيم السياسية والتاريخية والإنسانية عبر صور شعرية متعددة الطبقات باستخدام لغة رمزية. وتعد قصيدة الأرض نموذجاً بارزاً لهذا المنهج، حيث تظهر فيها عناصر الكرنفالية الباختينية بوضوح.
استخدم درويش في قصيدة الأرض لغة ترفض التصريح المباشر، معتمداً بدلاً من ذلك على الاستعارة والأسطورة والرموز الطبيعية مثل الأرض والأشجار والصخور والطيور. تحمل هذه الرموز ليس فقط دلالات سياسية، بل ترتبط أيضاً بأجساد المعذّبين والتاريخ المنسي لفلسطين. ومن بين الرموز الأسطورية المستخدمة في القصيدة يمكن ذكر «آذار»، «شمس أريحا»، «وطن الأنبياء» وغيرها.
جدير بالذكر أن كلمة «آذار» مشتقة من الجذر البابلي «هدر» الذي يعني «الارتجاف» و«الظلم». هذه المعاني تتناسب مع خصائص شهر آذار المعروف بصواعقه القاسية ورياحه وأمطاره. (عطية، 2009: 134) استخدم درويش أسطورة آذار لتصوير النهضة والبعث الجديد. أما «شمس أريحا» فهي رمز للاعتقاد التوراتي المنحرف الذي يؤمن بموجبه اليهود أن شمسهم يجب أن تشرق وتغرب في فلسطين موطنهم الأصلي؛ وبالتالي يصبح هذا الرمز تعبيراً عن حرية اليهود وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، حيث يشير «وطن الأنبياء» إلى قدسية أرض فلسطين ومدنها بما فيها القدس التي وُعد بها اليهود.
«في شهر آذار نَأتي إلی هَوسِ الذَّکریاتِ، وتَنمو عَلینا / النباتاتُ صاعَدةً في اتجاهاتِ کُلَ البِدایات./ خدیجَةُ لا تَغلَقي البابَ! / إنَّ الشَّعوبَ ستَدخُلُ هذا الکتابَ وتَأفل شمسُ أریحا / بدون طقوس./ فیا وَطَنَ الأنبیاءِ ... تکامَل!» (درویش، 2000: 323)
في هذه الأبيات، يوظف درويش صورًا رمزية تتقاطع مع مفاهيم الغروتيسك البختينية، حيث تتجلى فكرة التحول والولادة من خلال «النباتات الصاعدة» كدلالة على الزمن الجديد والبدايات المستمرة. النداء إلى خديجة بعدم إغلاق الباب يحمل بُعداً ساخراً، يعبّر عن رغبة في الحفاظ على فضاء مفتوح يسمح بدخول «الشعوب»، كأنه إشارة إلى فلسفة الكرنفال حيث تختفي التراتبية ويتم تجاوز الحواجز بين الخاص والعام. وفي ختام النص، يظهر الوطن كياناً ناشئاً أو غير مكتمل، يتطلّب المشاركة والانفتاح ليُكمل نفسه بفعل الجمعي والشعبي. هذه الصور مجتمعة تعكس توتراً بين الماضي والمستقبل، والموت والحياة، في فضاء شعري يحمل دينامية التحوّل والتجدّد.
«في شهرِ آذار مَرَّت أمامَ / الَبنَفسَجِ والبندقیة خَمسُ بناتٍ./ و اشتَعَلنَ مَعَ الوِردِ والزُعترِ البلدیّ./ و فی شهر آذار خمسُ بناتٍ یُخَبئنَ حَقلاً مِن القَمحِ تَحتَ الضَفیرهِ/ یا أیَّها الذَّاهبونَ إلی حَبة اَلقَمحِ في مَهدِها/ یقتبسُ البُرتقالُ اخضراري و صِبحُ/ هاجَس یافا/ أُسمّي الُترابَ امتداداً لِروحي/ أُسمي العصافیرَ لوزاً وتین أُسمي ضلوعي شجر/ وکلُّ الأناشیدِ فیکَ امتداداً لِزیتونةٍ زَمَّلتني.» (المصدر نفسه: 322)
بالإضافة إلى الرموز الأسطورية، استخدم درويش أيضًا رموزًا طبيعية؛ حيث اعتمد على استخدام الأزهار والأشجار والفواكه التي حظيت باهتمام الشاعر. في هذه القصيدة، يمثل «البنفسج» الدم، بينما ترمز «البندقية» إلى الحرب والاضطراب. اقتران هاتين الكلمتين معًا يعكس صراع الموت والحياة. كما يكشف «القمح» عن توق الشاعر، حيث يرمز في نظر الشاعر إلى عودته وعودة جميع اللاجئين إلى الوطن، أي فلسطين. ومن ناحية أخرى، يعكس هذا الرؤية الكرنفالية لدى درويش. ونظراً لعدم توفّر الظروف الملائمة للتعبير الصريح، فقد لجأ الشاعر إلى الكناية والاستعارة والرمز والأسطورة متستّراً بها، ليشير إلى الأجواء القمعية السائدة في الأراضي المحتلة.
خَمْسُ بَنَاتٍ يُخْبِئْنَ حَقْلًا مِنَ القَمْحِ تَحْتَ الضَّفِيرَةِ: إخفاء القمح تحت الضفيرة يرمز إلى الحفاظ على نوى المقاومة تحت غطاء المظهر الخارجي. هذه الصورة تتوافق مع مفهوم الجسد الغروتيسكي عند باختين الذي يؤكد على اتصال العناصر المتضادة (الظاهر/الباطن، الأنثوي/المقاوم). اشْتَعَلْنَ مَعَ الوَرْدِ وَالزَّعْتَرِ البَلَدِيِّ: اشتعال الفتيات مع الأزهار المحلية (الورد والزعتر) يرمز إلى تحويل العناصر الطبيعية إلى أسلحة نضال؛ سخرية طقسية تسخر من النظام السائد. يَا أَيُّهَا الذَّاهِبُونَ إِلَى حَبَّةِ القَمْحِ فِي مَهْدِهَا: الخطاب المباشر للجمهور يدعو إلى المشاركة الجماعية في رعاية رموز المقاومة (القمح). هذا النهج يذكرنا بالفضاء الكرنفالي حيث تتحطم الحدود الخطابية. يَقْتَبِسُ البُرْتُقَالُ أَخْضَرَارِيًّا:البرتقال الأخضر يرمز للأمل في ظل الحصار. هذه الصورة تخلق سخرية غروتيسكية من التقابل بين الحياة/الموت. هَاجَسْ يَافَا: تمثيل جغرافيا المقاومة كجسد مجروح؛ نهج يسميه باختين "الكرونوتوب" (ارتباط الزمان والمكان الرمزي).
في سياق التحوّل التاريخي، تحوّلت بعض المعتقدات الدينية إلى رموز، كما في حالة المسيح (ع) الذي يظهر كأحد هذه الرموز في قصيدة الأرض، حيث يصوّر الشاعر يوم النصر كقيامة ويستحضر شخصية المسيح (ع) مقدّمًا صورتين متباينتين له: الأولى كشخصية ضحيّة اغتيال ظالم، حيث تعبّر مفردات «جرح و ريح» عن ذروة الظلم والجور، بينما تظهر الصورة الثانية للمسيح (ع) كبطل ينهض من وسط نير الظلم والاضطهاد ليحقق التحرّر:
«هذا نشیدي/ وهذا خُروجُ المسیح مِنَ الجُرحِ و الرِّیح/» (المصدر نفسه: 318)
دمج المسيح (رمز الخلاص) مع «جرح»(رمز الألم) يعكس جدلية الأمل/اليأس، على غرار الكرنفال الذي يخلط التناقضات. الجرح لا يمثل مجرد جرح مادي، بل هو موقع رمزي للمعاناة التاريخية. هذه الصورة تتماشى مع تجسيد المفاهيم المجردة في الكرنفال الباختيني.
يمارس محمود درويش نقدا اجتماعيا مقترنا بسخرية وتهكم فلسفي. فهو لا يصب افكاره الفلسفية في قوالب المصطلحات الفلسفية الجافة، بل يعبر عنها عبر عناصره الشعرية برؤية احتجاجية ساخرة. عبر درويش باسلوب ممزوج بالسخرية والايحاء عن السخرية من الواقع المرير ونقده اللاذع للاوضاع السياسية والاجتماعية. سخرية درويش الشعرية لا تثير الضحك بل تغوص بالمتلقي في اعماق التأمل في المقولات، كما آمن بذلك ميخائيل باختين.
وفقاً لباختين، فإن «الضحك الكرنفالي هو ضحك احتفالي؛ له بعد كوني؛ يخاطب جميع الناس بما فيهم المشاركين في الكرنفال؛ هذا الضحك ثنائي الاتجاه، بهيج، منتصر، وفي نفس الوقت مقلد وساخر؛ ضحك مؤكد ونافي؛ ضحك يدفن ويحيي في آن.» (نولز، 1940: 80)
على هذا الاساس، فإن ضحكات درويش المريرة تتبخر سريعا من وجوه المتلقين لتحل محلها تأملات عميقة حول وطن الشاعر المحتل. في قصيدته الارض، يتحدث درويش عن الجرائم والاسر والاعتقال والقتل والارهاب والاحتلال والمذابح التي تعرض لها ابناء وطنه على مدى سنوات. في المقطع التالي، تخلق المفردات مثل البنفسج، البندقية، اشتعلن، قبضة، الظلال والغزاة فضاء ساخرا ومضحكا وفي نفس الوقت مثمرا للتفكير:
«في شهر آذار مَرّت أمامَ البَنَفسَجِ واَلبُندُقیة خمسُ بناتٍ/ واشتعلنَ مَعَ الوَردِ والزُعترِ البَلدي/ في شهرِ آذار أبي کانَ في قبضةِ إلانجلیز وأُمي تُربي جَدیلَتَها/ وفي شهر آذار تَأتي الظَّلالُ مریریةً والغُزاهُ بدونِ ظلالٍ.» (درویش، 2000: 320)
يتجلى أحد نماذج عناصر السخرية الفلسفية في شعر محمود درويش في تكرار عبارة «وفي شهر آذار...» في مستهل كل مقاطع القصيدة، حيث وقعت حادثة مقتل خمس فتيات فلسطينيات بريئات في هذا الشهر. كان مارس إله الحرب وأهم آلهة الرومان، حيث كان يعبد في جميع أنحاء جنوب ووسط إيطاليا. غالبا ما كانت تقام احتفالاته كإله للحرب في الربيع، الذي يمثل بداية موسم الحملات العسكرية، ومن هنا جاء تسمية الشهر الأول من التقويم الروماني القديم باسمه، وهو ما استلهمه درويش في استخدامه لهذه العبارة بهذا المفهوم.
من جهة أخرى، مارس كان يتمتع بحق الوصاية أو الحضانة على مدينة روما، حيث يشير الشاعر بشكل صريح إلى وصاية بريطانيا على فلسطين من خلال ربط مارس بالسقوط في قبضة البريطانيين. هذه الوصاية كانت كيانا جيوسياسيا تشكل في فلسطين بين عامي 1920 و1948 كجزء من تقسيم الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى تحت الانتداب البريطاني.
في الأبيات المذكورة، «خمس بنات»: الرقم خمسة (رمز النقص في الثقافة العربية) هو كناية ساخرة عن العجز الظاهري للمقاومة التي تتحول إلى عنصر متفجر بالاشتعال، تماما كما يحول الكرنفال الضعف إلى قوة. «البنفسج والبندقية»: الجمع بين الزهور الرقيقة (البنفسج) والأدوات العسكرية (البندقية) يخلق سخرية مفارقة من اتحاد الرقة والعنف.
«الغزاة بلا ظلال»: المحتلون بلا ظلال يسخر من القوى الاستعمارية التي تفتقر إلى الجذور التاريخية. هذا الطرح يتوافق مع وظيفة الهجاء في الكرنفال الباختيني الذي يزيل هالة القداسة عن المسيطرين.
تعزيز الفضاء متعدد الأصوات
في القصص الكلاسيكية، يقوم راوٍ واحد إما بضمير المتكلم أو راوٍ عالم بكل شيء بسرد القصة كاملة ويخلق الشخصيات كما يريد. بينما القصة ما بعد الحداثية هي قصة متعددة الأصوات لا تؤكد على صوت واحد فقط، حيث تقاوم الشخصيات القصصية الكاتب أو الراوي ويمتلك كل منها صوته الخاص.
ميخائيل باختين، المنظر والناقد الأدبي، نشر في عام 1929 أعماله حول بوطيقا دوستويفسكي حيث قدم منطق الحوار تحت اسم «تعدد الأصوات»؛ حوار يجري بين شخصيات القصة والكاتب والراوي مما يؤدي إلى ظهور آراء متنوعة وأحيانا متضادة. (ملاابراهيمي ورحيمي، 1396ش: 285)
يقسم باختين الحوارات في العمل الأدبي إلى نوعين: المونولوج (أحادي الصوت) والديالوج (متعدد الأصوات). الكاتب المكسيكي المعاصر أوكتافيو باث (Octavio Paz Lozano) يعتقد أن: «الحوار هو نوع من الحديث والاستماع. الشاعر أو الكاتب ليس فقط من يتكلم، بل هو من يستمع أيضا للكلام.» (پاز، 1369ش: 322)
يعتقد باختين أنه عند استخدام اللغة، هناك قوتان تؤثران عمليا: القوة المركزية والقوة الطاردة المركز. القوى المركزية تميل إلى جذب كل شيء نحو نقطة محورية، بينما القوة الطاردة المركز تميل إلى نشر كل شيء من نقطة محورية في اتجاهات مختلفة. وهو يرى أن اللغة أحادية الصوت تعمل مثل القوة المركزية، وهذه اللغة هي نظام من اللغة المعيارية أو الرسمية التي يجب على الجميع التحدث بها، بينما تعدد الأصوات يدفع اللغة نحو التعدد. (غلامحسين زاده وغلامپور، 1387ش: 117)
بهذا الاعتبار، يصور درويش باستمرار شخصيات متنوعة في قصائده التي تتبادل الحوار والمناقشة:
«قالَ لِي الحُبُّ یوماً: دَخَلتُ إلی الحلمِ وَحدي فَضعتُ/ وَضاعَ بي الحلِمُ. قُلتُ تکاثر! تَر النَهرُ یَمشي إلیکَ.» (درویش، 2000: 318)
في هذا المقطع من القصيدة، يمارس درويش الحوار الشعري، حيث تنحو قصيدته نحو المسرحية الشعرية، فهو يضفي على شعره طابعا ثنائي الصوت، وهذا الثنائي الصوتي في أشعاره يعبر عن الجدال بين اليأس والظلم من جهة، والأمل والإيمان بالنصر والحرية من جهة أخرى، حيث تكون الغلبة في النهاية للصوت الثاني.
في كتابه «مسائل بوطيقا دوستويفسك (problems of Dostoer skyspoetics) (1929) يعتبر باختين دوستويفسكي - بسبب وجود تعدد الأصوات، الوعي المنفصل وتعدد الأصوات الأصيلة في أعماله - مبدع الرواية «متعددة الأصوات»، ويعتقد أنه باستخدام منهج حواري، خلق فضاء نصياً يسمع فيه عدة أصوات بوضوح تتفاعل وتتحدث وتجيب بعضها البعض دون تفوق أحدهما على الآخر. (أحمدي، 1375ش: 101)
في المقابل لعالم الصوت الواحد، يوجد عالم درويش متعدد الأصوات. الشاعر، مع استخدامه لعناصر الطبيعة، يرسم فضاء يمكن لقارئ شعره أن يحل فيه الشخصيات الإنسانية مكان هذه العناصر ليصل إلى الفهم الصحيح للرسالة الكامنة في قلب الشاعر عبر هذا الحوار. إلى جانب ذلك، يخلق درويش باستخدام المنهج الحواري فضاء نصيا كرنفاليا تسمع فيه عدة أصوات تتفاعل وتتحاور دون تفوق أحدها على الآخر. في قصيدة الارض، يخلق درويش بلغة خطابية وأمرية فضاء متعدد الأصوات يذكر بالفضاء الكرنفالي عند باختين. «خديجة» و«الشاعر» في مقطع من هذه القصيدة هما من أكثر الشخصيات حيوية وتكرارا في النص حيث يجري بينهما حوار ومحادثة. في مقاطع مختلفة، يتواصل درويش مع خديجة بضمير المخاطب والغائب ويجري معها حوارا ويقر بأن الطريقة الوحيدة للخروج من المشاكل التي يعاني منها الشاعر نفسه والوطن وأبناء وطنه هي خلق حوار وتعاون بين جميع الفلسطينيين ليتمكنوا من الصمود أمام العدو المحتل وطرده، وبذلك يبشرون بأيام ومستقبل مشرق:
«خَدیجةُ! لاتَغلقي الباب!/ خدیجةُ!/ أینَ حفیداتُکَ الذاهبات إلی حُبِهِنَّ الجدید؟/ ذَهَبنَ لِیَقطفنَ بعضَ الحجارةِ/ قالَت خدیجةُ وَهي تَحثُّ النّدی خَلفَهُنَّ./ » (درویش ، 2000: 320)
خديجة! لا تغلقي الباب! هذا الأمر الجماعي لخديجة يمثل أصوات المجتمع التي تدعو خديجة للمشاركة في المقاومة. هذه العبارة تتماشى مع منطق الحوار الباختيني الذي يحل الفردية في الجماعة. أين حفيداتك الذاهبات... هذا السؤال عن مصير الجيل الجديد (الأحفاد) يعكس صوت الجيل القديم القلق على استمرار النضال. هذا السؤال يظهر جدلية الأمل/ الخوف في خطاب المقاومة. قالت خديجة... إجابة خديجة تمثل صوت المقاومة النسائي الذي يوجه الجيل الجديد لجمع الحجارة (رمز النضال). هذا الخطاب يتوافق مع تعدد الأصوات عند باختين الذي يجلب الأصوات المهمشة إلى المركز.
يبرز الشاعر تناقضاً أيديولوجياً بين جيلين: جيل الماضي الذي ربط الحب بالوطن والنضال من أجله، وجيل الحاضر الذي يعيد تعريف الحب باعتباره حباً في الحياة وتجربتها بحرية وبشكل مختلف. يظهر هذا التناقض بوضوح في صورة "حفيداتك الذاهبات إلى حبهن الجديد"، حيث تحمل كلمة "ذهاب" دلالة الحركة والانفصال، ليس من الجد فقط، بل من مفهومه للحب والنضال. هذا التعدد الصوتي في الرؤى بين الأجيال ينسجم مع نظرية باختين في تعدد الأصوات أو ما يُعرف بـتعدد الألحان حيث تتعايش في النص أصوات متعددة، كل منها تحمل رؤيتها وقيمتها، دون هيمنة لصوت على آخر. هنا، لا ينكر حب الوطن، بل يعاد تشكيله ليصبح حباً في الحياة، كجزء من دينامية التحول والتجديد التي تحيي النص شعرياً وتضفي عليه طابعاً غروتيسكياً يمزج بين القديم والجديد، والفردي والجمعي، والذاكرة والمستقبل.
الواقعية الغروتيسكية
الغروتيسك يعني السخرية والتهكم؛ وهو مصطلح يمكن دراسته في إطار مفهوم الكرنفال. «الغروتيسك يشير إلى نوع من الزخرفة باستخدام الأحجار الكريمة والتماثيل والأغصان والصخور والحصى. استخدم هذا المصطلح للإشارة إلى اللوحات التي صورت مزيجا من الإنسان والحيوان والنبات.» (كادن، 1380ش: 181) حدث توسع في المعنى الدلالي لهذه الكلمة كمصطلح أدبي في القرن السادس عشر. رغم أن الغروتيسك تم رفضه في العصر الكلاسيكي ولم يتم تقديم تعريف دقيق ومتماسك له، إلا أنه حظي باهتمام خاص في عصر النهضة، حيث يمكن تتبع جذوره في السخرية الشعبية في العصور الوسطى. النظرة واللغة الساخرة تجاه ظواهر الوجود هي من السمات البارزة للغروتيسك. «الغروتيسك هو تناقض غير محلول بين عناصر غير متجانسة، أحدها يأخذ شكلا كوميديا.» (تامسون 1390ش: 34)
الغروتيسك هو مزيج من عدة مشاعر متناقضة ويجمع بين الأضداد. وفقا لباختين، يجمع الغروتيسك كل شيء ويحشد العناصر المطرودة معا، ويرفض جميع المفاهيم السائدة. (باختين، 1387ش: 32) الغروتيسك في نظرية باختين هو أداة لقلب المعايير وعكس منطق الكرنفال الذي يتحدى الهيمنات المسيطرة من خلال الأجساد غير المكتملة والسخرية المريرة وتعدد الأصوات. أبرز سمات الغروتيسك التي يهتم بها باختين هي التنافر والمبالغة والتطرف واللانمطية، وفي نفس الوقت إثارة الخوف والضحك. يظهر الغروتيسك بشكل بارز في شعر محمود درويش، حيث تلعب المفارقة التناقضية دورا مهما في استخدام هذه المفاهيم:
«هذا التُرابُ تُرابي/ و هذا السَّحابُ سَجایی/ وهذا جبینُ خدیجة/ أنا العاشق الأبدیُّ – السَّجینُ البدیهي/ رائحةُ الأرضِ تُوقِظُني في الصباح المُبکَّرِ» (درویش، 2000: 323)
بناء على نظرية الغروتيسك عند باختين ومناهج النقد الدلالي، فإن التناقضات الموجودة في شعر محمود درويش تعمل كأداة تحررية لكسر المعايير. استخدام المفارقة في عبارة «السجين البديهي» (الأسير الجوهري) وغيرها من التناقضات الشعرية يمكن تحليله على النحو التالي: تحويل الأسر إلى «صفة وجودية جوهرية» يغير الدلالة المعيارية من «السجن=نفي» إلى «السجن=التزام». هذه الفكرة تتماشى مع رؤية باختين التي تشوش الحدود بين التحرر والأسر. كذلك فإن مفاهيم البعد والقرب في قصيدة الأرض تؤكد هذه المشاعر المتناقضة، حيث يخلق الشاعر من خلالها دفعة فكرية صادمة لدى المتلقي، وهذا التنافر بين عنصري الرعب والسخرية يولد نوعا من الحيرة والتردد في تحديد ما إذا كان العمل مضحكا أم مرعبا، وهي إحدى السمات البارزة للغروتيسك:
«وَ في شهرِ آذار تکتشُفُ الأرضُ أنهارَها/ بِلاِدي البیعدَة عنّي ... کَقلبي!/ بِلادي القریَبةَ مِنّي .... کَسِجني!» (المصدر نفسه: 318)
في الواقع، يستخدم محمود درويش مفارقة البعد/القرب («بلادي البعيدة عني... كقلبي! / بلادي القريبة مني... كسجني!») ليعكس الغروتيسك الباختيني عبر التوتر بين السخرية والرعب. هذا التناقض يوحي في آن واحد بالارتباط العاطفي (الوطن كقلب الشاعر) والأسر الوجودي (الوطن كسجن)، مما يؤدي إلى حيرة دلالية لدى المتلقي: فمن جهة، يرتبط الوطن البعيد بقلب الشاعر ويوحي بحب لا ينفصم، ومن جهة أخرى يتحول الوطن القريب إلى سجن يقيد الحرية. هذا التنافر المتعمد، المتوافق مع غروتيسك باختين، يشوش الحدود بين السخرية (سخرية الأسر الذاتي) والرعب (رعب الاحتلال)، ويجعل المتلقي في حيرة من تحديد توجهه العاطفي (ضحك أم قلق). مثل هذه الآلية، عبر كسر معايير الثنائية العاطفية، تدمج في آن واحد الأمل (الارتباط العاطفي بالوطن) واليأس (الأسر المفروض)، وتحول الغروتيسك إلى أداة لتمثيل أزمة الهوية الفلسطينية.
تحدي قيم الخطاب السائد
خلال الكرنفال، يتم تعليق القوانين والمحظورات والقيود التي تحدد بنية النظام في الحياة العادية، أي الحياة غير الكرنفالية: اولا يتم تعليق البنية الهرمية للعلاقات، وكذلك جميع اشكال الرعب والخوف، الخضوع والطاعة، التقوى والعفة وآداب السلوك المرتبطة بها، وبعبارة اخرى كل ما هو نتاج عدم المساواة الاجتماعية او الهرمية او اي شكل اخر من عدم المساواة بين الناس (حتى العمر). يتم تعليق المسافات بين الناس وتسود فئة كرنفالية خاصة: التواصل الحر والحميم بين الناس. هذا جانب مهم جدا من التفسير الكرنفالي للعالم. (باختين، 1400ش: 270) الناس الذين تفصلهم في حياتهم حواجز هرمية لا تقبل الجدل، يتجمعون في ساحة الكرنفال في ارتباط حميمي حر. هذه الفئة الخاصة من التواصل الحميمي هي التي تشكل طبيعة الافعال الجماعية الخاصة وكذلك حركات الرأس واليد الكرنفالية والخطاب الصريح للكرنفال.
وبالتالي، يتم تحرير السلوك والايماءات والخطاب الشخصي من سيطرة جميع المراكز (بما في ذلك المركز الاجتماعي، الرتبة، العمر والثروة) التي تكرس بالكامل للحياة غير الكرنفالية؛ لذلك تعتبر هذه المراكز من وجهة نظر الحياة غير الكرنفالية غير مألوفة وغير مناسبة. (المصدر نفسه: 271) في شعر محمود درويش، يمثل تحدي جميع المفاهيم والقيم والمعايير والقوانين نهجاً من خطاب الكرنفال، وهذه المناهج النقدية تجاه القيم الرسمية والمعتمدة من الخطاب السائد يمكن دراستها على ثلاثة مستويات: «الاجتماعي الثقافي»، «السياسي» و«الأدبي».
المستوى الاجتماعي الثقافي
محمود درويش الذي عرف بـ«الشاعر الوطني» للفلسطينيين، بدأ حياته بحماس وحب للوطن، والكفاح ضد الظلم والدعوة للسلام والمحبة، لم يكتفِ بكتابة الشعر عن المقاومة وحب الوطن فقط؛ رغم أن الطفولة والحياة والحب الأرضي والموت هي أيضاً مواضيع تحتل مكانة خاصة في قصائده الملحمية الغنائية. لم يستطع درويش الصمت أمام استشهاد خمس فتيات فلسطينيات على باب مدرسة ابتدائية في 30 مارس 1976 على يد معتد إسرائيلي. فظاعة جريمة قتل الفتيات دفعت الشاعر إلى نظم قصيدة تستحضر من خلال ذكر القضايا الأرضية، أساطير الموت والحياة. أساس هذه القصيدة هو الدفاع عن حقوق الفتيات الفلسطينيات اللاتي استشهدن مظلومات على أيدي وحوش إسرائيليين، وهو الأمر الذي كرره عدة مرات في المقاطع الأولى من قصيدته:
«وَفي شهرِ آذار، في سنة الانتفاضة، قالَت لَنا الأرضُ/ أسرارَها الدَّمویةَ: خَمسُ بناتٍ علی بابِ مدرسةٍ/ ابتدائیة یقتحِمنَ جُنود المظلات./ خمسُ بناتٍ علی/ بابِ مدرسةٍ ابتدائیةٍ ینکَسِرن مرایا مرایا» (درویش، 2000: 320)
لذلك، فإن الأبيات المذكورة تمثل نموذجا للكارنفالية الشعرية حيث يتم تمثيل الشهادة والمظلومية كتجربة جماعية، وتصوير أساطير الموت والحياة في قالب أرضي ملموس، ويطرح المقاومة الإنسانية ضد الظلم والاستعمار كنهضة اجتماعية وثقافية. هذا النهج يعكس الاعتقاد الاشتراكي العميق لدى درويش الذي يؤكد على نهوض الإنسان المعاصر ضد الظلم والاستعمار، ويحول فضاءه الشعري إلى ساحة للحوار الحقيقي والحر بين أنظمة القيم المختلفة، تماما كما يرى باختين الكرنفال كفضاء للحوار الحر ونقد البنى المسيطرة.
المستوى السياسي
يقدم شعر محمود درويش على المستوى السياسي، وخاصة في مواجهة الفضاء الأحادي والقمعي السائد، نقداً مريراً وساخراً للمحتلين الإسرائيليين بشكل فني عميق، مستخدماً عناصر الكرنفال الباختينية. من خلال تعبير «أقسى الشهور» الذي أطلقه على شهر آذار/ مارس، يقرب درويش الفضاء السياسي من الفضاء الكرنفالي، حيث يتم تحدي النظام الرسمي الأحادي للسلطة بلغة ساخرة مريرة وإلغاء للألفة الدلالية.
«آذارُ أقسی الشهور وأکثرُها شَبَقَاً/ خدیجةُ! لا تَغلَقي البابَ خَلفَک/ لا تَذهَبي في السَّحابِ/ سَتَمطُرُ هذا النَّهار/ سَتَمطُرُ هذا النهار رصاصاً/ سَتَمطُرُ هذا النَّهار/ فیا وَطن الأنبیاء تکامَل» (المصدر نفسه: 322)
على المستوى السياسي، يحمل درويش هموماً ومخاوف أخرى تعود جذورها لما قبل عام 1948، أي حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين (1920-1948)، وجزء آخر يعود لما بعد عام النكبة وحرب العرب مع اليهود. حيث تقرر وفقاً لمؤتمر سان ريمو أن تتولى بريطانيا إدارة المنطقة التي قسمت لاحقاً إلى فلسطين وشرق الأردن والعراق، مما أضاع آمال العرب في إقامة دولة مستقلة في المناطق المحررة من السيطرة التركية، وصادق عصبة الأمم على هذا التقسيم ومنحت بريطانيا وفرنسا حق الانتداب لإدارة هذه الأراضي تمهيداً لاستقلالها المستقبلي. الانتداب على فلسطين الذي منح رسمياً عام 1922، كلف بريطانيا مهمة إقامة وطن لليهود، وتسهيل هجرة الصهاينة، وتشجيع التوطن المكثف لليهود في مناطق غرب نهر الأردن. (بليك ودراسيدل، 1369ش: 368)
عقب احتجاجات سكان فلسطين على السيطرة البريطانية المؤقتة، قضوا فترة في السجن والقيود مع الحزن والمعاناة. من ناحية أخرى، منذ إصدار وعد بلفور، بدأ الشعب الفلسطيني كفاحه ضد الصهاينة، لكن منذ أربعينيات القرن الماضي أصبحت القضية الفلسطينية قضية عربية، مما أدى إلى العديد من الحروب والنزاعات بين العرب والصهاينة، منها حروب أعوام (1948، 1956، 1968، 1973، 1976) التي يذكرها محمود درويش تحت مسمى «خمس حروب»، ويصور معاناته ومعاناة أبناء جلدته قبل وبعد عام 1948 بهذه الطريقة:
«و في شهر آذار، قبل ثلاثین عاما وخمس حروب/ وُلِدت علی کومة من حشیش القبور المضئ/ و أبي کان في قبضة الانجلیز/ و أمي تربي جدیلتها وامتدادي علی العشب» (درویش، 2000: 317)
في النهاية، رغم كل هذه الهموم والمتاعب، يطالب الشاعر شعبه بالصمود ومواصلة المقاومة والجهاد ضد العدو المحتل الغاصب، لطرده من أراضيهم وبشرى بأيام سعيدة قادمة؛ أيام تذكرنا بمشاهد الاحتفالات الكرنفالية:
«في شهر آذار نَمتَدُّ في الأَرضِ/ في شهر آذار تنَتشُر الأرضُ فینا/ مواعیدَ غامضةً/ وَاحتفالاً بسیطاً/ وَنکتَشِفُ البَحرَ تحت النوافِذِ» (المصدر نفسه: 317)
في هذا السياق، يتجلى أحد عناصر الكرنفال البختيني على المستوى السياسي بشكل واضح من خلال توظيف الزمن (شهر آذار) كفضاء مفتوح للانعتاق والولادة الجديدة، وهو ما ينسجم مع فكرة الكرنفال كزمن للانقلاب على الوضع القائم وعبور الحدود. فالشاعر يربط بين الماضي المؤلم («قبل ثلاثين عاماً وخمس حروب») والولادة على «كومة من حشيش القبور المضئ»، وهي صورة غروتيسكية تجمع بين الموت والحياة، لتظهر الصراع كجزء من دورة وجودية مستمرة. وفي المقابل، يظهر في البيوتات الأخيرة مشهد احتفالي بسيط يتناغم مع روح الكرنفال: «واحتفالاً بسيطاً / ونكتشِف البحر تحت النوافذ»، حيث يعبّر عن تجاوز الحدود الرمزية (البحر كفضاء مفتوح) وعن الانعتاق من القيد عبر صور تجمّع بين الأرض والانتماء والحرية. وهكذا، يوظف درويش لغة الكرنفال السياسية كفضاء مقاوم يمزج بين الذكرى والولادة، وبين الألم والاحتفال، لیعيد تشكيل الوعي الجمعي ويدعو إلى التمرد على الواقع المفروض ويبقي باب الأمل مفتوحاً.
المستوى الأدبي
جميع القصائد التي نظمها شعراء فلسطينيون مختلفون حتى الآن تشترك في سمة واحدة هي البساطة في التعبير ووضوح الصور والمحاكاة، والسبب في ذلك أن جمهور شعر المقاومة يتكون في المقام الأول من جماهير العرب المقيمين في الأراضي المحتلة. منذ منتصف الخمسينيات، كلما نظمت المجتمع العربي الإسرائيلي مهرجانا للشعر في أي زمان أو مكان، استقطب انتباه عدد كبير من المستمعين. كانت قرية كفر ياسين عام 1957 موقعا لأحد هذه المهرجانات حيث ألقى 12 شاعرا فلسطينيا قصائدهم للحضور العربي، وكانت معظم القصائد تدور حول ثلاثة محاور: الأرض، القرية، والفلاح. «حبيب قهوجي» (أحد شعراء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين) يصف سبب أهمية هذه المهرجانات للأقلية العربية في إسرائيل بهذا القدر، وتأثير هذه التجمعات على الشعراء الذين عرفوا لاحقا بـ«شعراء المقاومة»، فيقول: «في الواقع، منذ عام 1948 أصبحت مهرجانات الشعر تقليدا للأقلية العربية المحتلة. ينتظر الناس هذه المهرجانات بفارغ الصبر كما ينتظرون الأعياد الوطنية والدينية. هذه المناسبات تثير في قلوبهم نفس المشاعر الجميلة التي تثيرها قراءة الشعر في السهرات والاجتماعات المسائية. كما كان لتقليد إلقاء الشعر تأثير عميق على الجيل الشاب وأثار اهتمامهم بالشعر. ميل الشباب لقراءة التراث الشعري العربي الغني، جعل سياسة الحكومة في التجاهل المتعمد وعدم تدريس الأدب العربي في المدارس الحكومية عديمة الجدوى. بالإضافة إلى ذلك، نقلت هذه المهرجانات أسماء وشهرة شعراء مثل محمود درويش وسميح القاسم وآخرين إلى ما وراء حدود إسرائيل وانتشرت في جميع أنحاء العالم العربي. هذه الأسباب دفعت الشعراء إلى التعبير عن أفكارهم بشكل بسيط وواضح حتى يتمكن المستمعون والقراء من فهم مضامينهم الفكرية». (سليمان، 1376ش: 231) «يجب أن يتذكر الشاعر أن شعره ليس لعامة الشعب في أرض أو أمة معينة، بل هو للإنسانية وللإنسان أينما كان. هو لا يكتب لليوم الذي يعيش فيه فقط، بل يكتب لجميع الأيام والعصور». (الدسوقي، 2003: 264) بناء على ما تقدم، فإن درويش يتخذ نهجا أكثر وضوحا في ارتباطه بهذا الموضوع؛ فهو يستخدم في نظم قصائده كلمات ومفردات بسيطة وصورا واضحة وجلية؛ أي أنه في شعره يميل إلى التوجه اليساري:
«کَأَني أعودُ إلی ما مضی / کَأني أسیرُ أمامي/ وَبینَ البِلاط وبینَ الرَّضا / أُعیدُ انسجامی/ أنا وَلَد الکلماتِ البَسیطة/ وَشهیدُ الخَریطة/ أنا زهرةُ المِشمِشِ العائلیة/». (درویش، 2000: 319)
في هذه الأبيات، يتجلى أحد العناصر الأدبية المهمة في فلسفة الكرنفال البختيني، ألا وهو الحوارية أو تعدد الأصوات (البوليفونيّة)، حيث نجد تداخلاً بين أصوات وأدوار متعددة داخل الذات الشاعرة: «أنا وَلَد الکلماتِ البَسیطة / وَشهیدُ الخَریطة / أنا زهرةُ المِشمِشِ العائلیة». فالشاعر هنا لا يتحدث بصوت واحد ثابت، بل يتنقل بين أصوات متعددة تمثل أبعاداً مختلفة من الهوية: هناك الصوت الذاتي (الفرد)، والصوت العائلي (الجذور)، والصوت الوطني (الخریطة) والصوت الشعري (الكلمات البسيطة).
ومن خلال هذا التعدد الصوتي، يتشكل فضاء شعري يحمل طابع الكرنفال، حيث يفقد الصوت الرسمي أو المركزي هيمنته، ويمنح كل صوت حقه في الوجود والتعبير، مما يخلق حالة من اللامركزية والحيوية الأدبية. هذا التفاعل بين الأصوات، المترافق مع صور رمزية بسيطة وحميمية مثل «زهرة المشمش العائلية»، يعكس روح الكرنفال الأدبي التي تكسر التراتبية وتفتح المجال للصوت الشعبي والشخصي ليشارك في بناء الخطاب، في مواجهة الخطاب الرسمي أو التاريخي.
النتیجة
إن تحليل المؤشرات الكرنفالية في قصيدة "الأرض" لمحمود درويش على ضوء نظرية ميخائيل باختين یظهر كيف يوظف الشاعر أدوات اللغة والرمز لخلق فضاء شعري يقاوم الهيمنة الثقافية والسياسية، ويحول الألم الوطني إلى مادة فنية تعبّر عن الصراع بطريقة تجمع بين الواقعية والخيال، والسخرية والحزن، والموت والولادة . ومن خلال هذا التحليل، تظهر الكرنفالية في ثلاثة مستويات متداخلة: ثقافية-اجتماعية، سياسية، وأدبية ، تتكامل لتشكّل نقدًا رمزياً عميقاً لنظام الهيمنة الصهيونية، وتعيد بناء الوعي الفلسطيني من موقع مقاوم.
على المستوى الثقافي الاجتماعي ، يستخدم درويش صوراً من الحياة اليومية مثل المشمش، الحجارة، والعشب، ليرتبط بجذور الأرض والهوية الشعبية، ويسقط من خلالها التراتبية الثقافية التي يفرضها خطاب الاحتلال. هذه الرموز الأرضية البسيطة، تصبح أدوات لـ إعادة امتلاك المكان والزمن،، وفق منطق الكرنفال الذي يعيد الاعتبار للصغير والهامشي، ويضعه في موقع المركزي والفاعل. فـزهرة المشمش ليست مجرد زهرة، بل هي رمز الجذور العائلية والانتماء، والحجارة ليست مجرد تراب، بل شهود على التاريخ، والعشب ليس مجرد نبات، بل امتداد للجسد الفلسطيني في الأرض. هذه الرموز، التي تبدو بسيطة، تكتسب دلالة سياسية ورمزية عميقة عندما تعرض في فضاء شعري كرنفالي يعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والمكان.
أما على المستوى السياسي ، فإن الشعر عند درويش يصبح أداة تمرد ساخرة، تعتمد على السخرية المريرة وإعادة تشكيل الأساطير . فشهر "آذار" الذي يرمز عادة إلى الولادة والانبعاث، يتحول في القصيدة إلى زمن للصراع والمعاناة، وهو ما ينطبق على مفهوم باختين للكرنفال كفضاء لـ إعادة تشكيل القيم ، حيث تقلب الصورة، ويتحول المقدس إلى ساخر، والمؤلم إلى مفتوح أمام الاحتمالات. فالشاعر لا يكتفي بإدانة الاحتلال، بل يعيد تشكيل خطابه، ويظهره في صورة مفككة وغير مقدسة، ويخلق فضاءً يسائل فيه الخطاب الأحادي للسلطة الصهيونية ، ويطرح صوتاً آخر متنوعاً ومختلفاً، يعبّر عن هوية فلسطينية غير منسجمة مع هذا الخطاب.
وأخيراً، على المستوى الأدبي ، يتجلى الكرنفال في البنية الشعرية ذاتها ، حيث يوظف درويش الغروتيسك والبنية المفارقة كأدوات لخلخلة القيم الجمالية السائدة، وتحويل اللغة إلى وسيلة للمقاومة. فالصورة الشعرية التي تجمع بين الموت والحياة، والقريب والبعيد، والحب والقهر، تعبّر عن تناقضات الوجود الفلسطيني، وتظهر كيف يمكن للشعر أن يصبح فضاءً للصراع والانعتاق في آن واحد . وعبر هذه البنية الغروتيسكية، يحقق درويش ما يسميه باختين بالواقعية الغروتيسكية، حيث يدمج بين العنف الواقعي (مثل مقتل الفتيات أو السجن والاحتلال) والاستعارات الشعرية (مثل الانكسار المرآتي أو البحر تحت النوافذ)، لخلق تأثير يمزج بين الألم والسخرية، والاحتجاج والأمل.
وبهذا، تتحول القصيدة إلى فضاء كرنفالي بلا حدود ، يكسر الحدود بين الذات والآخر، بين الحاضر والماضي، بين اللغة والسياسة، وبين الفرد والمجتمع. ففلسطين لا تعرَض هنا كضحية سلبية، بل ككيان حيّ وفاعل، يقاوم عبر الكلمة والصورة، ويخلق لنفسه سرداً بديلاً، سرداً ملحمياً يُعيد بناء الذات في وجه خطاب التهميش والطمس. وهذا ما يجعل شعر درويش، خصوصاً قصيدة الأرض، تجربة شعرية تتجاوز الإبداع الفني لتُصبح فعل مقاومة ثقافية ، تتماهى مع روح الكرنفال البختيني: حيث يعاد تشكيل القيم، ويمنح الصوت المختلف حقه في الوجود والتعبير.
بالتالي يمكن القول بأن الدرويش في قصيدة الأرض، باستخدامه معظم عناصر الكرنفالية الباختينية (تعدد الأصوات، السخرية الغروتيسكية، الواقعية الأرضية والتفكيك الرمزي)، لا يزعزع فقط خطاب الاحتلال أحادي الصوت، بل يحول الجغرافيا الشهيدة لفلسطين إلى نص حي تصبح فيه المقاومة جمالية وأنطولوجية في آن معا. الشاعر يخلق فضاء متعدد الأصوات من خلال دمج تعاليم القرآن والكتاب المقدس، الأساطير والرموز الفلسطينية، حيث تدخل الخطابات الدينية والتاريخية والسياسية في حوار دائم. هذا النهج يعكس منطق الحوارية عند باختين حيث لا تفوق لصوت على آخر، وتتشكل الهوية الجماعية من تصادم الأصوات المتعددة. هكذا ينجح درويش في تحويل الشعر إلى فضاء تحرري، حيث تذوب الحدود بين الفن والمقاومة، بين الجمالي والسياسي، بين الفردي والجماعي، مخلّفا إرثاً أدبياً يثبت أن الكلمة يمكن أن تكون أقوى من الرصاص حين تتحول إلى فعل مقاومة خلاق.
المصادرو المراجع
أحمدي، بابک. (1375ش). ساختار و تأویل متن، چاپ سوم، طهران: نشر مرکز.
باختین، میخائیل. (1387ش). تخیّل مکالمه ای ، ترجمه رویا پورآذر، طهران: نشرنی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (۱۳۷۲ش). دوبلین فرنیستر: فلسفه زبان شناسی. ترجمة محمدعلی اسلامی ندوشن، طهران: نشر فرهنگستان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (۱۳۸۲ش). فرهنگ عامه در روسیه دیرباز: نمایشها، جشنها، زبان شفاهی. ترجمة حسن انوشه، طهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
بلیک و دراسیدل، جرالد اچ و آلاسدیر. (۱۳۶۹ش). جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه میر حیدر مهاجرانی، طهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
تامسن، فیلیپ. (1390ش). گروتسک، ترجمة فرزانه طاهری، طهران: نشر مرکز.
درویش، محمود. (2000). الأعمال الشعریة الکامِلة، الطبعة الثانیة، بغداد: دارالحریة للطباعة و النشر.
الدسوقی، عمر. (2003). فی الأدب الحدیث، بیروت: دارالفکر.
سلیمان، خالدا. (1376ش). فلسطین در شعر معاصر عرب، ترجمه شهره باقری- دکتر عبدالحسین فرزاد، چاپ اول، تهران: نشر چشمه.
عطیه، بشیر عبد زید. (2009). «أشهر السنة ودلالتها فی الشعر العراقی الحدیث، مجلة القادسیة فی الآداب والعلوم التربویة»، المجلد8. العدد3.
غلامحسین زاده، غریب رضا و غلامپور، نگار. (1387ش). میخائیل باختین: زندگی، اندیشه ها و مفاهیم بنیادین، طهران: نشر روزگار.
کادن، جی آی. (1380ش). فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، طهران: شادگان.
ملاابراهیمی، عزت و رحیمی، صغری. (1396ش). «تحلیل مؤلفه های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا»، مجله زبان و ادبیات عربی، شماره 16، صص 275-306.
نظری، راضیه و نجفی ایوکی، علی. (1398ش). «نشانه شناسی سروده قصیده الارض محمود درویش با تکیه بر نظریه نشانه شناسی گریماس»، فصلنامه پژوهش های ادبی بلاغی، سال هفتم، شماره 26، ص 68.
نولز. (1940). شکسپیر و کارناول پس از باختین، ترجمة رویا پورآذر، طهران: انتشارات هرمس.