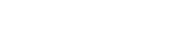A psychological and social study of the characters in the novel "Al-Thajjah" by the Yemeni writer "Fakriya Shahra"
Subject Areas : Literary criticism
Hosein Taktabar Firouzjai
1
![]() ,
mahdi naseri
2
,
mahdi naseri
2
![]() ,
Zohreh Roshan Zamir
3
,
Zohreh Roshan Zamir
3
![]()
1 - Assistant Professor in the University of Qom
2 -
3 - Master of Arts in Arabic Language and Literature. Payam Noor University, Shahreza Branch, Isfahan Province
Keywords: : Yemeni novel, Fikria Shihra, “Al-Thajja” novel, characters, social psychological study, identity,
Abstract :
Yemeni author Fikria Shihra's novel "Al-Thajja" addresses the multiple and complex issues that the characters face as they face the challenges and ups and downs of their lives due to social and political pressures. The novel explores the impact of traditional norms on individuals and reveals the struggles of "Mukhtar" as he seeks to balance raising his son, "Omar," with social traditions. The motivation behind this study is evident in Shihra's intellectual desire to present studies that address the emotions of the various characters and how social and political circumstances shape their lives. The novel highlights the psychological effects of family relationships, as both Salem and Ghalia strive to achieve self-realization in defiance of social pressures, making challenging traditional norms an important goal within the overall context of the novel. The aim of the study is reflected in providing a cultural and psychological awareness of Yemeni identity in the midst of political and social transformations, as the characters reflect experiences of isolation and failure, along with aspirations for hope and the will to change. The results of the study indicate that the novel adopts a narrative approach that manipulates emotions, confronting the reader with complex issues surrounding the conflict between the past and the future.
ابن فارس، أحمد. (1979م). معجم مقاييس اللغة، ج 3. (تحقيق عبد السلام محمد هارون، المحرر) دار الفكر.
ابن منظور، محمد بن المُكرّم. (1987م). لسان العرب، مادة سرد (المجلد الثالث). (تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، المحرر) القاهرة: دار المعارف.
اقاخانی بیژنی، محمود. (۱۳۹۶). جلوه های ترس و اضطراب در رمان زمین سوخته،نقد ادبی، دوره ۱۰، ش ۳۷
باختين، ميخائيل. (1987م). الخطاب الروائي. (محمد برادة، المترجمون) القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع.
برنس، جيرالد. (2003م). المصطلح السردي (ط 1). (عابد خزندار، المترجمون) القاهرة: المجلس العربي للثقافة.
البستاني، بطرس. (1987م). محيط المحيط. بيروت: مكتبة لبنان.
بو عزة، الطيب. (2016م). ماهية الرواية. بيروت - لبنان: عالم الأدب للبرمجيات والنشر والتوزيع.
بو عزّة، محمد. (2010م). تحليل النص السردي "تقنيات ومفاهيم" (ط 1). الرباط: دار الأمان.
زيتوني، لطيف. (2002م). معجم مصطلحات نقد الرواية. بيروت: مكتية لبنان ناشرون ودار النهار للنشر.
شحرة، فكریة أحمد علي. (2020م). روایة الثجة، (ط 1). القاهرة: دار أروقة.
شعبان، هيام. (2004م). السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر الله. الأردن: دار الكندي.
فتحي، ابراهيم. (1988م). معجم المصطلحات الأدبية. صفاقس - تونس: المؤسسة العربية للناشرين المتحدين.
الفراهيدي، الخليل بن أحمد. (2003م). العين. بيروت: دار الكتب العلمية.
الفريروزآبادي، محمد بن يعقوب. (2005م). القاموس المحيط، مج1 (ط 8). (إشراف محمد نعيم، المحرر) بيروت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.
قصراوي، مها حسن. (2004م). الزمن في الرواية العربية (ط 1). بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
قيسومة، منصور. (2013م). اتجاهات الرواية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. تونس: الدار التونسية للكتاب.
يقطين، سعيد. (مارس, 2000م). كتابة تاريخ السرد العربي. المفهوم والصيرورة. السعودية: مجلة علامات في النقد.
يوسف، آمنة. (2015م). تقنيات السرد في النظرية والتطبيق. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
العلاقة بين مقاومة شخصية "أبو عبد" في قصة "القميص المسروق" لغسّان كنفاني ومحاور نظرية تدرج الحاجات لإبراهام ماسلو
عليأکبر نورسیده (الكاتب المسؤول)
أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إیران
مدیحة کریمي
طالبة الدکتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها، بجامعة سمنان، سمنان، إیران
تاريخ الاستلام: تاريخ القبول:
الملخص
يُصوِّر أدب المقاومة معاناة الإنسان في مواجهة الظروف القاسية المفروضة، وذلك عبر الكشف عن الضغوط الاجتماعية والسياسية. وقد أفضى هذا التوجه إلى تسليط الضوء على الروابط بين الأدب وعلم الاجتماع وعلم النفس، وإلى نشأة النقد السيكولوجي. في هذا السياق، قدَّم أبراهام ماسلو نظريته المعروفة بـتدرج الحاجات، التي تُبيّن كيفية تأثير الحاجات الإنسانية على أفعال الفرد وعلاقاته. تهدف هذه الدراسة، المعتمدة على المنهج الوصفي التحليلي، إلى بحث ثبات أو تغيُّر النمط المقاوم لشخصية أبي عبد في قصة "القمیص المسروق" للكاتب الفلسطيني غسّان كنفاني، وتحديد الكيفية التي أثّرت بها مقاومة أبي عبد، في ضوء تدرج ماسلو للحاجات، على سلوكياته وعلاقاته وقراراته. خلصت نتائج البحث إلى أن مقاومة أبي عبد كانت في البداية سلبية وداخلية، لكن تفجُّر رغبته في تحقيق العدالة حوّلها إلى مقاومة عدوانية. علاوة على ذلك، أدت مقاومته في مواجهة إحباط حاجاته الأساسية إلى تفعيل آليات دفاعية لديه مثل التجنب والكبت والإزاحة. ومع ذلك، فإن هاجس المعيشة منعه من مقاومة برود علاقاته، لكن على مستوى اتخاذ القرارات، فإن مقاومته قد حالت دون انصياعه لإغراءات الذات وقیامه بالسرقة.
الكلمات الدلیلیّة: أدب المقاومة، غسّان كنفاني، القميص المسروق، أبراهام ماسلو، نظریة تدرج الحاجات.
المقدّمة
يحرص الأدباء، لا سيما في مجال أدب المقاومة1، على تجسيد القضايا الإنسانية ضمن إطار جماليات الأدب في صلب أعمالهم، بهدف التعبير عن القيود المكبلة والحيرة الناجمة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية الصعبة والكشف عنها. فالهدف من هذا النوع الأدبي هو تصوير آلام وصراعات البشر الذين وقعوا فريسة لظروف سياسية قاهرة. (الجيوسي، 1997م: 96) يسهم هذا النطاق، من خلال تمثيلاته العميقة للأزمات الروحية، في إثراء النص الأدبي وتعميقه، ويمهد الطريق للكشف عن العلاقة الجوهرية بين علم النفس وعلم الاجتماع والأدب. وبهذه الوسيلة، وبفضل جهود منظّري القرن العشرين، أمثال سيغموند فرويد2، ظهر منهج "النقد النفسي". كان فرويد أول منظّر طبّق مفاهيم ونظريات التحليل النفسي على تحليل النصوص الأدبية، وفتح آفاقاً جديدة للقراءات الأدبية من خلال تحليل الأطر السردية.
إلا أنه إلى جانب المناهج النفسية التي ركزت بشكل أساسي على دراسة التحديات النفسية وعلم الأمراض الشخصية، تيار آخر، ركز اهتمامه على أسباب نجاح الأفراد. ومن أبرز ممثلي هذا التيار، يُذكر عالم النفس الإنساني الأمريكي أبراهام هارولد ماسلو3. اشتهر ماسلو عالمياً بنظريته المعروفة بـ "هرم ماسلو للحاجات الإنسانية4". في الواقع، عارض ماسلو السلوكية والتحليل النفسي الفرويدي، إذ اعتقد أن «حصر علم النفس في البحث في الأمراض العصابية والذهنية سيؤدي إلى إعاقة علم النفس ودفعه نحو الهاوية.» (شولتز، 1990م ب: 342) يكشف هذا المنهج، ولاسيما في سياق أدب المقاومة، كيف تؤثر المستويات المختلفة للحاجات الإنسانية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها على أفعال الفرد وعلاقاته، وتؤدي إلى انهيار الشخصيات في حال الحرمان. لذا، يسهم تحليل الأعمال الأدبية في ضوء هذه النظريات في تسهيل فهم نسيج الشخصيات ودوافعها الكامنة من خلال كشف جوانبها الذهنية والنفسية، وبالتالي تحقيق فهم عميق للأفراد في هذا العالم المتغير.
بناءً عليه، تسعى الدراسة الحالية إلى تطبيق هذه النظرية على عمل أدبي في مجال أدب المقاومة. ونظراً للطابع العالمي للقضية الفلسطينية كرمز للمقاومة ضد الظلم والاستكبار، تم اختيار قصة "القميص المسروق" - وهي أولى قصص المجموعة القصصية "القميص المسروق" - للكاتب والصحفي الفلسطيني غسّان كنفاني، الذي ترعرع منذ البداية في مدرسة المقاومة، لتكون محور هذا البحث. ركز كنفاني في كتاباته على فلسطين والمشكلات الناجمة عن الحرب واحتلال هذا البلد. ويُعد في الأدب الفلسطيني المعاصر «أول كاتب استخدم مصطلح المقاومة في الأدب لأول مرة، وأطلق اسم "أدب المقاومة الفلسطيني" على مجموعة من قصائد وقصص شعراء وكتاب فلسطينيين.» (ترابي، 2011م: 150) لذا، فإن دراسة مثل هذه الأعمال، التي نشأ كاتبها في بيئة مليئة بالتحديات والمشكلات الناجمة عن الأجواء المتوترة في فلسطين، وربما يكون قد ذاق مرارة إخفاق حاجات كل مستوى من مستويات هرم ماسلو، يمكن أن تقدم صورة أوضح للمقاومة في مواجهة الحاجات الإنسانية غير الملباة والحالات النفسية والصراعات الفردية والاجتماعية الناجمة عنها. وفي هذا السياق، تظهر قصة "القميص المسروق" توافقاً أكبر مع نظرية أبراهام ماسلو مقارنة بأعماله الأخرى، وذلك بسبب انعكاس حاجات الهرم المذكور فيها، مما أدّى إلى اختيار هذه القصة.
أسئلة البحث
تسعى الدراسة الحالية للإجابة عن الأسئلة الآتية:
١. كيف يُقيّم ثبات أو تغيّر نمط المقاومة لدى شخصية "أبو عبد" في قصة "القميص المسروق"؟
٢. كيف أثرت مقاومة شخصية "أبو عبد"، في ضوء هرم ماسلو للحاجات، على سلوكه وعلاقاته وقراراته؟
في هذا الصدد، تسعى الدراسة الراهنة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وبالاعتماد على مراجعة الكتب والبحوث المتعددة التي أُجريت حتى الآن في هذا المجال، إلى تقديم إجابات شافية لأسئلتها.
الدراسات السابقة
في مجال أدب المقاومة، أُجريت دراسات حول قصة "القميص المسروق" ونظرية أبراهام ماسلو لتسلسل الحاجات. فيما يلي أقرب الدراسات إلى البحث الحالي:
أدب المقاومة في أعمال غسّان كنفاني
مقالة بعنوان «المبادئ النظرية لأدب المقاومة في أعمال غسّان كنفاني» بقلم محمد صادق بصيري ونسرين فلاح، نُشرت عام 2014م في مجلة أدب المقاومة. تشير النتائج إلى أن الكاتب، بناءً على آلام طفولته في الشتات، يعكس حزن وظلم الشعب الفلسطيني ويعتبر المقاومة السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.
مقالة بعنوان «تحليل مكونات أدب المقاومة في رواية "رجال في الشمس" لغسّان كنفاني» بقلم نعيم عموري وسيد حسن نجاتي، نُشرت عام ٢٠١٩م في مجلة البحث في تعليم اللغة العربية وآدابها. تُظهر النتائج أن كنفاني يعتبر إسرائيل السبب الرئيسي لمشاكل فلسطين؛ لكنه يعتقد أن صمت الشعب الفلسطيني وعدم اعتراضه على معاناته يمنعهم من الانتصار على العدو، ولذلك، فإنه يحث الناس بكتاباته على التفكير والنهوض لتحرير أنفسهم.
رسالة ماجستير بعنوان «مظاهر أدب المقاومة في المجموعة القصصية القصيرة "عن الرجال والبنادق" للكاتب غسّان كنفاني» بقلم هنا خضيري نيسي، نوقشت عام 2023م تحت إشراف نعيم عموري في جامعة شهيد تشمران الأهواز. تشير نتائج البحث إلى أن الكاتب أكد على حب الوطن، ومحاربة الظلم، والتضامن، ومعرفة العدو، والشوق إلى الشهادة، واليقظة في مواجهة التهديد الصهيوني والإنجليزي.
المجموعة القصصية "القميص المسروق"
مقالة بعنوان «سيميائية اجتماعية للقصة القصيرة "القميص المسروق" لكنفاني بالاعتماد على التراكيب الخطابية لهاليداي5» بقلم تورج زيني وند وسمية صولتي، نُشرت عام 2017م في مجلة اللغة العربية وآدابها. تُظهر النتائج أنه على مستوى الفكرة، يوجد في بداية القصة خطاب يدفع بالشخص الفلسطيني نحو الهامش ويواجهه بمشاعر تسبب له الميل إلى الخيانة، لكن إدراك الحقيقة يمنعه من الخضوع لهذه الخيانة ويدفعه للانتقام من العدو. على المستوى التفاعلي، تصور علاقات شخصيات القصة الانتقال من الشك إلى اليقين في سياق الخيانة. على مستوى النص، أسهم التكرار والإحالة في زيادة تماسك النص.
رسالة ماجستير بعنوان «ترجمة وشرح رواية "القميص المسروق" من العربية إلى الفارسية للكاتب غسّان كنفاني» بقلم ميلاد حسّاويان، نوقشت عام 2022م تحت إشراف علي أكبر ملائي في جامعة ولي عصر رفسنجان. تُظهر النتائج أن الكاتب استخدم في قصصه شخصيات عربية قريبة وملموسة من شوارع فلسطين، حيث صور الشعب الفلسطيني فرداً فرداً وأظهر معاناتهم بشكل كامل.
نظرية أبراهام ماسلو
مقالة بعنوان «تحليل الشخصية الرئيسية في رواية "أيام معه" بناءً على نظرية أبراهام ماسلو لتحقيق الذات» بقلم بيمان صالحي وكلثوم باقري، نُشرت عام 2022م في مجلة الأدب العربي. تُظهر النتائج أن وجود العادات والتقاليد الخاطئة في هذه القصة حرم النساء والفتيات من تحقيق الذات وتطوير إمكاناتهن. تحتاج الشخصية الرئيسية في هذه القصة فقط إلى داعم لإزالة العقبات من أجل تحقيق الذات.
مقالة بعنوان «دراسة الشخصية الرئيسية في رواية "اختفاء السيد لا أحد" بناءً على نظرية أبراهام ماسلو» بقلم عباس قنجعلي، فائزة إيزي وسيد مهدي نوري كيذقاني، كُشفت عام 2024م في مجلة نقد الأدب المعاصر الأدبي. تُظهر الدراسات أن الشخصية الرئيسية تصل إلى تحقيق الذات من خلال امتلاك "قيم الكينونة" والتحرك في مسار ما بعد الحاجات.
مقالة بعنوان «توصيف الشخصيات في رواية "ملك الهند" لجبور الدويهي استناداً إلى نظرية أبراهام ماسلو» بقلم مجيد صالح بك وهايده عجرش، كُشفت عام 2025م في مجلة دراسات الأدب القصصي. معظم شخصيات الرواية منغمسة في الحاجات الأساسية ولا تصل إلى تحقيق الذات؛ ولكن في شخصية زكريا، يمكن ملاحظة مكونات تحقيق الذات في نهاية المطاف بسبب صراعاته الداخلية.
من خلال الدراسات المذكورة، يتضح أنه لم يتم حتى الآن تناول قصة "القميص المسروق" بالتركيز على النظريات النفسية، بما في ذلك نظرية أبراهام ماسلو.
الأسس النظرية
أبراهام ماسلو وتفسير نظرية تدرج الحاجات
وُلد أبراهام هارولد ماسلو عام 1908م في حي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية. منذ سنوات طفولته الأولى، اتجه إلى الدراسة والقراءة، وفي السابعة عشرة من عمره التحق بالكلية. في العشرين من عمره، غيّر حدثان حياته بشكل ملحوظ: الزواج والتعرف على علم النفس السلوكي6. درس وبحث في السلوكية لعدة سنوات، لكن ولادة طفله غيّرت وجهة نظره تجاه السلوكية. في رأيه، لا يمكن لمن يصبح أباً أن يظل سلوكياً. قدم ماسلو الإنسانية7 كموجة ثالثة في علم النفس بعد التحليل النفسي والسلوكية. في الواقع، كان الهدف الأساسي لماسلو هو فهم مدى قدرة الإنسان على التطور والازدهار. ويعتقد أن هناك ميلاً فطرياً لدى البشر لتحقيق أقصى إمكاناتهم. (شولتز، 2006م: 87-91)
في عام 1943م، قدم ماسلو نظرية تحفيزية، مستعيراً مفهوم تحقيق الذات من أعمال كورت غولدشتاين8 ومكملاً آراء السابقين، بنيت على مجموعة من الحاجات الفطرية والمتدرجة، ويؤدي تلبية هذه الحاجات إلى الشعور بالرضا عن الحياة. (راس، 2003م: 132) وفقاً لهذه النظرية، يتمتع جميع الأفراد بدافع لتحقيق الذات، وإذا تم تلبية حاجاتهم المرحلية، وبمساعدة الذكاء والإرادة، بالإضافة إلى التحكم في العوامل البيئية المسببة للتوتر والتحدي التي تؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية، يمكنهم تحقيق الذات من خلال تطوير المواهب التي تمهد الطريق للوصول إلى الكمال. (فرانك، 1991م: 223)
يرى ماسلو أن تحقيق الذات صفة عامة جداً، ويمكن أن تتجلى في أي نوع تقريباً من السلوك. «ليس الرسام أو الموسيقي أو الكاتب أو الممثل وحده من يحقق ذاته، بل كل شخص في أي مكان، في عملية أن يصبح أكثر انسجاماً وتكاملاً واكتمالاً كشخص، هو في الواقع على طريق تحقيق الذات.» (كارفر وشير، 2008م: 518) بالإضافة إلى إيمانه بتأثير البيئة كعنصر أساسي في ازدهار المواهب الفردية، يعتقد ماسلو، خلافاً لفرويد، أن الإنسان ليس لديه فطرة شريرة. بحيث أنه إذا توفرت بيئة لتلبية حاجاته، فمن الممكن أن يصل إلى الكمال الإنساني. في رأيه، ما يوجه سلوك الإنسان هو تدرج حاجاته. (ماسلو، 1988م: 138)
على الرغم من أن هذا التدرج غالباً ما يمثل على شكل هرم، إلا أن ماسلو نفسه لم يرسم هرماً ولم يدعمه. بعد حوالي عشرين عاماً من طرح ماسلو لهذا التدرج، قام عالم نفس استشاري بتصويره لأول مرة في مجلة تجارية. الحاجات الخمسة التي تشكل هذا التدرج هي حاجات إرادية؛ أي أنها ذات طبيعة جهدية وتحفيزية. (فيست وآخرون، 2022م: 389)
هذه الحاجات من أدنى مستوى إلى أعلاها هي كالتالي: أولاً: الحاجات البيولوجية أو الفسيولوجية9: هذه الحاجات ضرورية لبقاء الإنسان واستمرار حياته، مثل الغذاء والملبس والمأوى. ثانياً: الحاجات الأمنية10: أي عدم تهديد صحة الإنسان وممتلكاته وحياته من قبل العوامل البيئية. ثالثاً: الحاجة إلى الحب والانتماء11: الحاجة إلى إقامة علاقات عاطفية وحب متبادل مع الآخرين. رابعاً: الحاجات المتعلقة بتقدير الذات12: إدراك الفرد لقيمته الوجودية واعتقاده بأنه يحظى بالاحترام من قبل الآخرين. إذا لم يحقق الأفراد الاحترام اللازم لهم باستخدام أساليب بناءة، فمن الممكن أن يلجأوا إلى سلوكيات غير سوية للوصول إليه. خامساً: الحاجة إلى تحقيق الذات13: أي يجب توفير بيئة لتطوير المواهب الكامنة. من المسلم به أن تحقيق الحاجات التي تقع في قمة الهرم يستلزم تحقيق حاجات المستويات الأدنى. (ماسلو، 1988م: 138)
الصورة (1). هرم ماسلو للحاجات (سيّد عبد الرحمن، ١٩٩٨م: ٤٣٦)
بالإضافة إلى هذه الحاجات الأساسية الخمس، حدد ماسلو ثلاث فئات أخرى من الحاجات:
الحاجات الجمالية14: بخلاف الحاجات الأساسية التي تتسم بالعمومية، فإن هذه الحاجات ليست شاملة؛ ولكنها تحرك بعض الأفراد على الأقل في كل ثقافة نحو الحاجة إلى الجمال والتجارب الفنية الممتعة. الحاجات المعرفية15: يميل معظم الناس إلى المعرفة، وحل الألغاز، والفهم، والفضول. أطلق ماسلو على هذه الميول اسم الحاجات المعرفية. الحاجات العصابية16: هذه الحاجات غير صحية وغير مجدية. إنها تديم أنماط الحياة غير الصحية ولا تساهم في تحقيق الذات بأي شكل من الأشكال. عادةً ما تكون الحاجات العصابية تفاعلية، وبعبارة أخرى، تنشأ لتعويض الحاجات الأساسية غير الملباة. (فيست وفيست، 2005م: 597-596)
الأدب المقاومة في فلسطين
تَشكّل الأدب المقاومة الفلسطينية في خضم الفوضى والاضطرابات التي أعقبت احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الصهاينة عام 1948م، وما تلاه من تهجير الفلسطينيين. ومنذ البداية، أثرى الشعراء والكتاب الفلسطينيون هذا الأدب وأغنوه يوماً بعد يوم، من خلال إبداعاتهم الشعرية والقصصية والمقالات النقدية والاجتماعية التي نشرت في الدوريات.
يعود مصطلح "أدب المقاومة" بجذوره إلى نضالات الشعب الفلسطيني. وكان غسّان كنفاني (1936-1972م)، الكاتب والصحفي والمناضل الفلسطيني الشهيد، وأحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أول من استخدم هذا المصطلح. ففي عام 1966م، جمع كنفاني مجموعة من قصائد الشعراء الفلسطينيين في كتاب أسماه "أدب المقاومة في فلسطين". وفي المقدمة المطولة لهذا الكتاب، تناول كنفاني النشاطات الأدبية للفلسطينيين المهجرين والمنفيين، وقدم أدب المقاومة الفلسطيني إلى العالم. وهكذا، فتح مصطلحا "المقاومة" و"أدب المقاومة" طريقهما إلى اللغات والثقافات الأخرى، وانتشرا كتسمية لنوع خاص من الأدب. (ترابي، 2011م: 250)
ملخّص قصة "القميص المسروق"
هذه القصة هي الأولى من كتاب "القميص المسروق" لغسّان كنفاني (1936-1972م)، والذي يضم ثماني قصص قصيرة. تصور القصة حياة عائلة فلسطينية مكونة من ثلاثة أفراد، حيث أدت إقامتهم في خيام مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى بروز تحديات في حياتهم. يتعرض ربّ الأسرة، أبو عبد، لوم زوجته المستمر بسبب البطالة وعجزه عن تأمين الحاجات الأساسية كالطعام؛ لذا تدفعه هذه الصعوبات إلى التفكير في السرقة، ويُحرضه أبو سمير – أحد سكان المخيم – على ذلك. لكن بعد أن يكتشف سبب تأخر توزيع الطحين على العائلات، والذي كان ناتجاً عن صفقات أبي سمير مع الضابط الأمريكي، يتجنب السرقة ويقتل أبا سمير.
بحث ودراسة
الحاجات الفسيولوجية
تُمثّل الحاجات الفسيولوجية، كما أسّسها أبراهام ماسلو، الركيزة الجوهرية لوجود الإنسان ككائن مُعقّد. يُشدّد ماسلو على أن «إشباعها أكثر ضرورة بكثير من حاجات المستويات العليا. فالشخص الذي يفتقر إلى الطعام والأمن والحب والاحترام، يتملّكه شغف أكبر تجاه الطعام.» (ماسلو، 1993م ب: 71) وتتضمن هذه الحاجات: الهواء، الغذاء، الماء، المأوى، الدوافع الجنسية، والنوم.
الغذاء
غالباً ما يُهيمن توفير الغذاء على سائر الحاجات الفسيولوجية، لدرجة أن ماسلو يرى أن «الأشخاص الذين يعانون من الجوع المستمر، دافعهم الوحيد هو الأكل. لا شيء يهمهم سواه، وما دام هذا الاحتياج غير مُلبّى، سيظل دافعهم الأساسي هو البحث عن قوتهم.» (فیست وآخرون، 2022م: 389) في قصة "القميص المسروق"، يشكّل توفير الغذاء محور الحاجات الأساسية لأبي العبد.
«وَلَكِنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ هَذِهِ الْخَيْمَةَ، إِنَّ فِي مُحَاجِرِ زَوْجِهِ سُؤَالاً رَّهِیباً مَّا زَالَ يَقْرَعُ فِيهِمَا مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ، لَا، إنَّ الْبَرْدَ أَقَلُّ قَسْوَةً مِّنَ السُّؤَالِ الرَّهِيبِ. سَتَقُولُ لَهُ إِذَا مَا دَخَلَ وَهِيَ تَغْرِسُ كَفَّيْهَا فِي الْعَجِينِ، وَتَغْرِسُ عَيْنَيْهَا فِي عُيُونِهِ: هَلْ وَجَدْتَ عَمَلاً؟ مَاذَا سَنَأْكُلُ إِذَنْ؟....وَنَصَبَ قَامَتَهُ بِهُدُوءٍ لَّاهِثٍ، ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ عَادَ، فَاتَّكَأَ عَلَى الرَّفْشِ الْمَكْسُورِ، وَأَنْشَأَ يُحَدِّقُ بِالْخَيْمَةِ الدَّاكِنَةِ مُسْتَشْعِراً قَلَقاً عَظِیماً.» (كنفاني، ٢٠١٣م: ٨)
تُنهك زوجة أبي العبد زوجها باستمرار بأسئلتها المتكررة وتوبيخاتها، نتيجة عجزه عن تلبية الحاجات الأولية كالغذاء. تُشكل هذه التوبيخات هجوماً مباشراً على هوية أبي العبد الرجولية، ما يُحطّم معنوياته ويدفعه إلى تفضيل قسوة البرد خارج الخيمة على الدفء الداخلي المصحوب بتوبيخات زوجته. في هذا الموقف، ينتابه قلق شديد، فيلجأ إلى آلية الدفاع بالتجنب17 لمقاومة هذا القلق. تُعرّف هذه العملية بأنها تجنب الفرد للأعمال والمواقف غير المريحة للابتعاد عن الانزعاج. (فرويد، 2018م: 126) ويبدو أن سلوك أبي العبد هذا، المتمثل في عدم دخول الخيمة ومواجهة أسئلة زوجته، يمثل مقاومة سلبية ومحاولة لحماية ذاته من المشاعر السلبية والقلق الناجم عن هذا التفاعل. بالإضافة إلى ذلك، وبما أن «الضغوط الناتجة عن القلق يمكن أن تكون محفزاً لتفعيل آلية الدفاع الكبت18؛ وهذا يعني أن التجارب غير السارة والمثيرة للقلق تُدفع إلى اللاوعي لحماية الفرد من المعاناة الناجمة عن ذلك القلق.» (فيست وفيست، 2005م: 38)، يمكن القول إن نفس أبي العبد تلجأ إلى آلية الدفاع الكبت، وهي شكل من أشكال الثبات الداخلي، في محاولة لطرد وقمع الأفكار السلبية الناجمة عن عجزه عن توفير مستلزمات الأسرة وتوبيخات زوجته المتواصلة، بعيداً عن وعيه.
يرى ماسلو أن «الأفراد الجائعين ينصب كل اهتمامهم وفكرهم على الطعام، ويتخذون أي إجراء لتوفيره.» (فيست وآخرون، 2022م: 398) تدفع الضغوط النفسية الناتجة عن انعدام الغذاء أبا العبد إلى التفكير في أفعال غير أخلاقية: «هُوَ يَسْأَلُ نَفْسَهُ: وَمَاذَا لَوْ سَرَقْتُ؟.» (كنفاني، 2013م: 8) يتضح أن مسألة الطعام تُسهم في توجيه أفكاره نحو السرقة والصراع بين "الهي19 والأنا20"21 لديه. فالهي يسعى إلى اللذة وغير عقلاني، وهدفه تحقيق اللذة دون اعتبار للصواب أو الخطأ. أما الأنا، فهي المجال الوحيد في العقل الذي يتصل بالواقع وتسعى إلى إحلال الواقع محل لذة الهي. (السيد عبد الرحمن، 1998م: 47-50) إن سؤال أبي العبد لنفسه: ماذا لو سرقت؟ يدل على ذروة الصراع بين الهي والأنا. في الواقع، يسعى الهي إلى الإشباع الفوري للحاجة، دون اكتراث بالعواقب أو الاعتبارات الأخلاقية، ومن هنا يطرح إغراء السرقة كحل ممكن وسريع. لكن الأنا، بتقييمها للواقع والنتائج المحتملة لهذا الفعل، تتدخل وتحاول مقاومة دافع الهي بتقديم حل منطقي ومقبول. ويمكن اعتبار هذه المقاومة صراعًا للحفاظ على الكرامة الإنسانية والأطر الأخلاقية في ظل ظروف متدهورة.
يعتقد ماسلو أن «الانشغال الوحيد للشخص الذي عانى من الجوع لفترة طويلة هو الطعام. في مثل هذه الحالة، يرى الفرد الطعام فقط في يقظته ومنامه، ولا يدرك سواه، وكل فكره وهمه هو الطعام.» (ماسلو، 1993م ب: 72) لقد استحوذ توفير الطعام على ذهن أبي العبد لدرجة أدت إلى حدوث زلة لسان22: «مَاذَا تَعْمَلُ يَا أَبَا الْعَبْدِ؟ إِنَّنِي أَحْفِرُ طحِيناً، تَحْفِرُ مَاذَا؟ أَحْفِرُ... أَحْفِرُ خَنْدَقاً.» (كنفاني، 2013م: 9) تتجلى هذه الزلة اللسانية أثناء محادثته مع أبي سمير، فلحظة الإجابة على سؤاله "ماذا تفعل يا أبا العبد؟"، يؤدي اختيار الكلمة الخاطئة "طحيناً" بدلاً من "خندقاً" إلى كشف أفكاره. وبما أن «العديد من الزلات اللسانية التي تحدث يومياً ليست عرضية، بل تشير إلى أهداف الفرد اللاواعية.» (فيست وفيست، 2005م: 71)، يمكن القول إن زلة لسان أبي العبد هذه هي صرخة لاواعية من أفكاره ورغباته العميقة المكبوتة، وتعبير عن الضغط العميق واللاواعي للحاجة إلى توفير الغذاء على ذهنه، مما أدى في النهاية إلى إبدال الكلمات.
حاجات الأمان
تُشكل المكونات المندرجة ضمن الحاجات الأمنية ركيزة أساسية للارتقاء بالإنسان. ففي هذه المرحلة، يسعى الفرد إلى تحقيق «الأمن، الاستقرار، الانتماء، الدعم، العمل، تكوين الأسرة، امتلاك الممتلكات، الحفاظ على الصحة والسلامة الجسدية، وغيرها.» (ماسلو، ١٩٩٣م الف: ٧٤) ووفقاً لهرم ماسلو فإن تلبية حاجات المستويات الأولى تُفضي إلى ظهور حاجات المستويات اللاحقة. فعند إشباع حاجات المستوى الثاني، تبرز حاجات المستوى الثالث، وهكذا. (ماسلو، 1988م: 9) وبالتالي، فإن أي قصور في تحقيق هذه المكونات يضع المراحل المتبقية أمام تحديات جسيمة، ويمثل أي سعي لتحقيق هذه العوامل أو الحفاظ عليها مقاومةً ضد الانهيار.
الأمن
تلعب الظروف البيئية والعوامل الاجتماعية دوراً حاسماً في توفير الأمن، وذلك للحماية من الأضرار الجسدية والنفسية والاقتصادية. يؤكد ماسلو أنه «عندما تتعرض النظم والقوانين وسلطة المجتمع للتهديد، يمكن أن تتحول حاجات الأمن إلى أولوية ملحة.» (ماسلو، ١٩٩٣م ب: ٧٨) تقدم قصة أبي العبد مثالاً واضحاً على هذه الحالة. يتضح من سرد الرواية أن هذه الحاجة تتسم بالإلحاح، إذ يغيب أي أثر للأمن في حياة أبي العبد نتيجة لغياب النظام والقانون الداعمين للناس. إن الحياة في خيام اللاجئين الفلسطينيين هي ثمرة عجز المنظمات الاجتماعية والسلطة عن اتخاذ التدابير الأمنية والوقوف في وجه عدوان العدو. وفي ظل هذه الظروف التي يخيم فيها انعدام الأمن على المجتمع، من المؤكد أن الجهود الفردية، إن وُجدت، لن تكون كافية لتوفير الأمن على المستوى العام.
تُسبب الحياة في مخيمات اللاجئين توترات عديدة، حصیلتها ضیاع الأمن. ففي مثل هذه الظروف، يواجه الإنسان، بالإضافة إلى احتمالية التعرض للمخاطر البيئية، صراعات داخلية أيضاً، لأن غياب فرص العمل ومحدودية الموارد، إلى جانب خلق منافسات غير صحية، قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والنفسي وغيرهما. ويشير ذلك إلى أن الهياكل المعيبة تُعيق الاستقرار الفردي والاجتماعي وتُساهم في تفاقم التوترات.
«اِسْمَعْ، إِنَّ مَا عَلَيْنَا هُوَ أَنْ نُخْرِجَ أكْيَاسَ الطَّحِينِ مِنَ المَخْزَنِ وَنَذْهَبَ بِهَا هُنَاكَ، إِنَّ الحَارِسَ سَيُمَهِّدُ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَفْعَلُ دَائِماً، إنَّ الَّذِي سَيَتَوَلَّى البَيْعَ لَيْسَ أنَا، وَلَا أنْتَ، إنَّهُ المُوَظَّفُ الأمِيرْكِيُّ الأشْقَرُ. الأمِيرْكِيُّ يَبِيعُ، وَأنَا أقْبِضُ، وَالحَارِسُ يَقْبِضُ، وَأنْتَ تَقْبِضُ، وَكُلُّهُ بِالِاتِّفَاقِ، فَمَا رَأيُكَ؟» (كنفاني، 2013م: 12)
بالنظر إلى أقوال أبي سمير وأفعاله، التي تشرح لأبي العبد كيفية السرقة من المستودع وتُبرر هذا الفعل، يمكن اعتبار هذا الجانب من شخصيته انعكاساً لوظيفة "الهُوَ". فالـ"هو" «يهرب من الوازع الديني، وهو فاسد، عنيد، أناني، ويسعى إلى تحقيق لذاته بأسرع وقت، ولا يبالي بالمستقبل.» (هريدي، 2011م: 95) يبدو أن "هو" أبي سمير، بوصفه الجزء الغريزي واللاواعي، يستغل تحريض أبي العبد على السرقة كوسيلة لتحقيق المنفعة واكتساب المال، متجاهلاً في سبيل ذلك العواقب الأخلاقية والقانونية. وهذا يشكل نوعاً من المقاومة الأنانية في مواجهة الحرمان، كما يُظهر هيمنة هذا الجزء من بنيته الشخصية على الاعتبارات الواقعية.
يُعد عجز أبي العبد عن تلبية الحاجات الأساسية، بالإضافة إلى جوع ومعاناة طفله وزوجته، التهديد الرئيسي لأمنه النفسي. ويتجلى هذا الانعدام للأمن في صراعاته النفسية التي تُظهر بوضوح ثبات مكونات شخصيته الداخلية:
«وَلَكِنَّهُ فِي الوَقْتِ ذَاتِهِ رَاقَهُ أنْ يَعُودَ يَوْماً إلَى خَيْمَتِهِ وَفِي يَدِهِ قَمِيصٌ جَدِيدٌ لِعبدالرحمن، وَأغْرَاضٌ صَغِيرَةٌ لِأُمِّ العَبْدِ بَعْدَ هَذَا الحِرْمَانِ الطَّوِيلِ، كَمْ سَتَكُونُ ابْتِسَامَتُهُمَا جَمِيلَتَيْنِ، إِنَّ ابْتِسَامَةَ عبدالرحمن، لِوَحْدِهَا، تَسْتَحِقُّ المُغَامَرَةَ لَا شَكَّ... و ... لَوْ نَجَحَ فَسَيَبْدُو عبدالرحمن إنْسَاناً جَدِیداً، وَسَیَقْتَلِعُ مِنْ عُیُونِ زَوْجِهِ ذَلِكَ السُّؤَالَ المُخِيفَ، لَوْ نَجَحَ، فَسَتَنْتَهِي مَأسَاةُ الخَنْدَقِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مُمْطِرَةٍ وَسَيَعِيشُ حَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ أنْ يَتَصَوَّرَ الآنَ الوصول.» (كنفاني، 2013م: 12)
تُعد الظروف الأسرية المضطربة المُحرك الأساسي لـ"الهُوَ" في ذات أبي العبد. حيث ينشغل هذا الجزء من ذهنه بتحقيق اللذة والرضا من خلال إسعاد زوجته وابنه بشراء المستلزمات الضرورية لهما. وسعياً لمقاومة الحرمان الطويل وتحقيق أهدافه، يجنح إلى طريق سريع، وهنا قد يُعزّز اقتراح أبي سمير بالسرقة هذه الوسوسة. إلا أن "الأنا"، باعتبارها الحصن الرئيسي للاستقرار والمقاومة في أبي العبد، تُولد أفكاراً تتعارض مع هذه الرغبات:
«وَلَكِنَّهُ لَوْ فَشِلَ... أيُّ مَصِيرٍ أسْوَدَ يَنْتَظِرُ أُمَّ العَبْدِ وَوَلَدَهَا يَوْمَهَا سَيَحْمِلُ عَبْدُالرَّحْمَنِ صُنْدُوقَ مَسْحِ الأحْذِيَةِ لِيَتَكَوَّرَ فِي الشَّارِعِ هَازّاً رَأسَهُ الصَّغِيرَ فَوْقَ الأحْذِيَةِ الأنِيقَةِ،يَا لِلْمَصِيرِ الأسْوَدِ.» (المصدر نفسه: 12)
تسعى "الأنا" في أبي العبد إلى إحداث توازن بين رغبات "الهُوَ" القائمة على مبدأ اللذة، وقيود الواقع، بالإضافة إلى قيم "الأنا العليا". ورغم ضغط حاجات الأسرة ووساوس أبي سمير، فإن "الأنا" تجعله يأخذ العواقب المحتملة للسرقة في الاعتبار. تُقدم "الأنا" صورة واضحة لمستقبل طفله المتمثل في تلميع أحذية الآخرين ومصيره المظلم في حال فشلت خطة السرقة، وهو ما يمكن اعتباره استراتيجية مقاومة ذهنية. في الحقيقة، تُشير هذه التصورات إلى سعي "الأنا" لفهم الواقع والمقاومة في مواجهة اندفاعات "الذات". وبما أن "الأنا" «هي الجزء الوحيد من العقل الذي يتصل بالعالم الخارجي، وتضطلع بدور صانع القرار أو الوكيل التنفيذي للشخصية.» (فيست وآخرون، 2022م: 45)، فإن "الأنا" تنتصر في النهاية، مع الأخذ في الاعتبار الأحداث الجارية والواقع:
«وَخَطَرَ لَهُ أنَّ ذَلِكَ الأمِيرْكِيَّ كَانَ يَبِيعُ الطَّحِينَ فِي الوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ فِيهِ لِرِجَالِ المُخَيَّمِ وَلِنِسَائِهِ إنَّ تَوْزِيعَ الإعَاشَةِ سَيَتَأجَّلُ إلَى نِهَايَةِ الأيَّامِ العَشْرَةِ الأُولَى مِنَ الشَّهْرِ، وَأحَسَّ بِنِقْمَةٍ طَاغِيَةٍ. لَوْ يَدْرِ کَیْفَ رَفَعَ الرَّفْشَ إلَى مَا فَوْقَ رَأسِهِ وَكَيْفَ هَوَى بِهِ بِعُنْفٍ رَهِيبٍ عَلَى رَأسِ أبِي سَمِيرٍ.» (كنفاني، 2013م: 14-15)
عندما يتأمل أبو العبد حرمان نفسه وأسرته وسكان المخيم الآخرين، الناجم عن أفعال الموظف الأمريكي الظالمة المتمثلة في بيع الدقيق وتأخير توزيعه، ينتابه غضب عارم. ويستغل لا شعورياً آلية الدفاع المسماة الإزاحة23، التي ينقل الفرد من خلالها مشاعره غير المناسبة من موضوع معين إلى آخر، أو من شخص معين إلى شخص آخر أكثر تقبلاً وأقل خطورة. (هريدي، 2011م: 99) يبدو أن أبا العبد يُفرّغ كل الغضب الذي كان يضمره تجاه الموظف الأمريكي بقتل أبي سمير، الذي يُحتمل أن يكون أقل خطورة عليه من الموظف الأمريكي. ويُشير هذا الغضب إلى مقاومته الأخلاقية للظلم والاستغلال، ويُمكن أن يكون قتل أبي سمير مؤشراً على استخدامه لآلية الإزاحة.
حاجات الحب والانتماء
عندما تُشبع الحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمان إلى حدٍ ما، تُصبح الحاجة إلى الانتماء والحب محفزاتٍ أساسيةً للسلوك. لذلك، «يُصبح لدى الفرد ميلٌ شديدٌ لإقامة علاقاتٍ حميمةٍ مع الآخرين، ويُعاني من ألمٍ شديدٍ وشعورٍ قاسٍ بالوحدة نتيجة فقدان الأصدقاء أو الزوج أو الأبناء.» (السيد عبدالرحمن، 1998م: 437) كما يرى ماسلو أن الترابط العاطفي والعلاقات الأسرية، والانتماء إلى المجموعات العائلية والصداقات ومجموعات العمل، هي من أهم مظاهر الحاجات الاجتماعية في هذا المستوى. (ماسلو، 1993م ألف: 9) ويمكن القول إن العلاقات الأسرية، نظراً لطبيعتها الأساسية والأعمق والأكثر استقراراً في الغالب، تلعب دوراً محورياً في هذا المستوى.
العلاقات الأسرية
تؤثر الحاجات الفسيولوجية وحاجات الأمان بشكلٍ كبيرٍ على جودة العلاقات البينية، وخاصةً العلاقات الأسرية. يعتقد ماسلو أن «الجنة المأمولة لشخصٍ يُصارع الجوع الشديد والطويل، ستكون على الأرجح مجرد مكانٍ يتوفر فيه الطعام بوفرة. وقد يعتبر الحب والانتماء الاجتماعي والتقدير والفلسفة مظاهر لا قيمة لها، لأنها لا تستطيع إشباع بطنه ولا تُقدم له أي فائدة.» (ماسلو، 1993م ب: 72)
في القصة المذكورة أيضاً، أثرت ظروف الحياة القاسية على الحاجات الاجتماعية، وخاصةً العلاقات الأسرية. في الواقع، إن هم أبي عبد الرئيس لتلبية الحاجات الأساسية قد قلل من الوقت والاهتمام الذي يُخصصه لتقوية الروابط العاطفية ومقاومة اهتزاز الأسرة. لكن في هذا السياق، فاقمت طريقة تعامل أم عبد مع المشكلات هذا التذبذب في العلاقات:
«وَلَکِنَّهُ یَخَافُ أنْ يَدْخُلَ هَذِهِ الخَيْمَةَ، إِنَّ فِي مُحَاجِرِ زَوْجِهِ سُؤَالاً رَّهِیباً مَّا زَالَ یَقْرَعُ فِیهِمَا مُنْذُ زَمَنٍ بَعِیدٍ، لَا، إنَّ البَرْدَ أَقَلُّ قَسْوَةً مِّنَ السُّؤَالِ الرَّهِيبِ. سَتَقُولُ لَهُ إِذَا مَا دَخَلَ وَهِيَ تَغْرِسُ كَفَّيْهَا فِي العَجِينِ، وَتَغْرِسُ عَيْنَيْهَا فِي عُيُونِهِ: هَلْ وَجَدْتَ عَمَلاً؟ مَاذَا سَنَأكُلُ إِذَنْ؟ کَیْفَ اسْتَطَاعَ (أبُو فُلَانٍ) أنْ يَشْتَغِلَ هُنَا، وَكَيْفَ اسْتَطَاعَ (أبُو عِلَّتَانَ) أنْ يَشْتَغِلَ هُنَاكَ؟ وَسَتَهُزُّ رَأسَهَا بِصَمْتٍ أبْلَغَ مِنْ ألْفِ ألْفِ عِتَابٍ... مَاذَا عِنْدَهُ اللَّيْلَةَ لِيَقُولَ لَهَا سِوَى مَا يَقُولُهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.» (كنفاني، 2013م: 8)
يُفضل أبو عبد البرد القارس على دفء الخيمة بسبب سلوك زوجته المُعاتب الذي يلومه على نقص الطعام والعمل، ومقارنتها المستمرة له برجال المخيم الآخرين. لكن في المقابل، كان بإمكان أبي عبد أن يُقاوم تفكك العلاقات العاطفية من خلال الحوار البناء، وشرح القيود، ومحاولة إثارة تعاطف زوجته. في المقابل، بدلاً من تبني أم عبد لنهج المقاومة في شكل التعاطف والتفاهم المتبادل، حوّلت البيئة الأسرية، التي ينبغي أن تكون المصدر الرئيسي للدعم العاطفي، إلى مصدر ضغطٍ من خلال أسئلتها المتكررة، ومعاتبتها المتواصلة، ومقارناتها المدمرة، وفي النهاية صمتها الثقيل. إن أفعال أم عبد، والمناقشات المُنهكة، وغياب التواصل الفعال، وعدم وجود جهد مشترك للتغلب على المشكلات، لم تُضف إلى مشاعر عدم الانتماء والنبذ لدى أبي عبد – وهو ما يؤكده خوفه من دخول الخيمة – فحسب، بل أدت أيضاً إلى الانفصال والوحدة لكلا الطرفين، وهو ما لا يُثمر إلا برودة وتضاؤل العلاقات الأسرية.
تُخلق مثل هذه الظروف تحدياتٍ أعمق للأطفال نظراً لهشاشتهم النفسية الأكبر: «ثُمَّ سَتُشِیرُ إلَى عبدالرحمن المُكَوِّرِ فِي زَاوِيَةِ الخَيْمَةِ كَالْقِطِّ المَبْلُولِ.» (المصدر نفسه: 8) يُظهر هذا الوصف أن عبدالرحمن مُتكوّر في زاوية الخيمة كقطٍ مبلول. ويمكن استنتاج أن غياب الطعام في هذه الظروف له قيمة نفسية بالنسبة لعبدالرحمن؛ لأن ماسلو يعتقد:
«الطفل الذي يُحرم من الحصول على مثلجاتٍ قد لا يفقد إشباعاً حسياً فحسب، بل قد يشعر بالحرمان من عاطفة أمه؛ وذلك لأنها رفضت شراء المثلجات له. في نظر الطفل، المثلجات لا تحمل قيمة جوهرية فحسب، بل يمكن أن تحمل قيماً نفسية أيضاً.» (ماسلو، 1993م ب: 160) بالنظر إلى مثال ماسلو الذي يُشير إلى أن شراء المثلجات يمكن أن يُفسر في نظر الطفل كرمزٍ للمحبة والاهتمام، ورفض شرائها كإهمالٍ من الوالدين، حتى لو كان سبب الرفض قيوداً مالية، أو الحفاظ على صحة الأسنان، أو أسباباً منطقية أخرى لا يفهمها الطفل.
في حالة عبدالرحمن، الظروف أصعب وأكثر تعقيداً بكثير؛ لأنه يواجه حرماناً متعدد الأوجه يُهدد بقاءه. في مثل هذه الحالة، يمكن أن تُلحق معاتبات أم عبد ضرراً كبيراً بعبدالرحمن؛ لأنه قد يُفسر غياب الطعام ليس بسبب الحرمان العام، بل بسبب قلة اهتمام والده به، وقد يرى مُشاجرة والدته تأكيداً لهذا التصور. في هذا الوضع، يبدو أن عبدالرحمن قد لجأ إلى السلوك التعبيري24 الذي طرحه أبراهام ماسلو. «السلوك التعبيري عادةً ما يكون غريزياً وتلقائياً وتُشكله القوى الداخلية للفرد. وتشمل أمثلة هذا السلوك التحدب، التصرف بحماقة، الاسترخاء، والتعبير عن الفرح.» (فيست وآخرون، 2022م: 397) في الواقع، يمكن أن يكون تجمع عبدالرحمن في زاوية الخيمة محاولةً لا واعية وسلوكاً تعبيرياً للتعبير عن الانزعاج، واللجوء، وكذلك جذب انتباه والديه لإثارة تعاطفهما ومحبتهما. إن تشبيهه بقطٍ مبلول يُظهر بوضوح حالته العاطفية الهشة، وضعفه، وعجزه، وحاجته إلى الدعم والدفء العاطفي. يبدو أنه في مثل هذه الظروف، كان بإمكان أبي عبد وزوجته أن يُعبرا عن الحب اللفظي أو الجسدي البسيط، وهو بحد ذاته نوعٌ من المقاومة ضد التفكك العاطفي للطفل، وأن يُرسيا شعور عبدالرحمن بالانتماء والاستقرار النفسي.
حاجات التقدير
تساهم عوامل مثل الشهرة، والمستوى التعليمي، والمكانة الاجتماعية، والثروة، في اكتساب الأفراد للاحترام. وقد ذكر ماسلو أن «حاجات هذه المرحلة تشمل الإنجاز، والكفاءة، والاستقلالية والحرية، والمكانة الاجتماعية، والحاجة إلى الاحترام.» (ماسلو، 1993م ألف: 80) يبدو أن عنصر الاستقلالية والحرية يحمل علاقة معقدة ومتناقضة أحياناً مع العناصر الأخرى في هذا المستوى. على سبيل المثال، قد يتطلب الحصول على مكانة اجتماعية عالية قبول قيود على الحرية الشخصية ضمن الأطر الاجتماعية والوظيفية.
الاستقلالية والحرية
إن بيئة المقاومة وما يترتب عليها من عدم إشباع الحاجات الدنيا تؤدي إلى إغفال الفرد لإخفاق الحاجات العليا. في هذا الصدد، يؤكد ماسلو أن «الرجل الذي يعيش على الكفاف لن يقلق كثيراً بشأن أمور الحياة الرفيعة، كالحرية، وحق التصويت، وسمعة مدينته، والاحترام؛ فإن اهتمامه سينصبّ قبل كل شيء على الحاجات الأساسية.» (ماسلو، 1993م ب: 115) إن الحياة في الظروف الصعبة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين تمثل مثالاً صارخاً على وضع يتناقض بشدة مع حاجات الاحترام، وخاصة الاستقلالية والحرية. ومع ذلك، وكما يتضح من الحوار بين أبي سمير وأبي العبد في القصة المذكورة، فإن هذه القيود الخارجية لا تؤدي بالضرورة إلى سلب كامل لحرية الفرد في التفكير واختيار الأفعال: «إِسْمَعْ إِنَّ هذَا الأَمِيرِكِيَّ صَدِيقِي، وَهُوَ إِنسَانٌ يُحِبُّ العَمَلَ المُنَظَّمَ، إِنَّهُ يَطْلُبُ مِنِّي دَائِماً أَنْ أَضَعَ الوَقْتَ بِالمُقَدِّمَةِ. وَهُوَ لَا يُحِبُّ التَّأخِيرَ فِي المَوَاعِيدِ... عَلَيْنَا أَنْ نَبْدَأَ الآنَ. أَسْرِعْ.» (كنفاني، 2013م: 14) و «لَا، بَلْ أَنْتَ المِسْكِينُ.» (المصدر نفسه: 12) يتضح من النص أن أبا سمير يقر بأن الرجل الأمريكي صديقه، وأنه يفضل العمل المنظم وفي المواعيد المحددة، كما يصف أبا العبد بأنه "مسكين".
يبدو أن أبا سمير يرى في السرقة وسيلة للهروب من القيود الشاقة للمخيم، ورغم هذه الظروف الصعبة، فإنه يتمتع بنوع من الحرية في اختيار هذا الفعل وتبني موقف انتهازي. يتوافق هذا إلى حد ما مع وجهة نظر فيكتور فرانكل25 الذي يعتقد أن «الإنسان مخلوق حر، وحتى الظروف البيئية لا يمكن أن تسلبه هذا الحق في الاختيار.» (شولتز، 1990م ألف: 156) في البيئات التي يسود فيها الشعور بالعجز والضعف، قد تؤدي محاولة تعزيز الثقة بالنفس الهشة إلى سلوكيات معينة. من هنا، يمكن استنتاج أن تأكيد أبي سمير على صداقته بشخص أمريكي ذي نفوذ، وتقديمه صورة منظمة ودقيقة عن نفسه، و وصف أبي العبد بالمسكين، يمثل محاولة لإظهار القوة وإصلاح تقدير الذات المتضرر، وكذلك مقاومة لقبول دور الضحية. ومع ذلك، فإن رد فعل أبي العبد يشير إلى أن المقاومة في ظروف مماثلة يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة، ويمكن للأفراد أيضاً أن يتبنوا مواقف مختلفة: «وَشَعَرَ أَبُو العَبْدِ أَنَّ القَضِيَّةَ أَشَدُّ تَعْقِيداً مِنْ سَرِقَةِ كِيسٍ أَوْ كِيسَيْنِ أَوْ عَشَرَةٍ وَرَاوَدَهُ شُعُورٌ لَزِجٌّ بِالقَرَفِ مِنَ المُعَامَلَةِ مَعَ هَذَا الإنْسَانِ.» (كنفاني، 2013م: 12) و «فِي كُلِّ خِيَامِ قَرِيَةِ النَّازِحِينَ كَانَتِ العُيُونُ المُتَلَهِّفَةُ تَقَعُ فِي خَيْبَةِ الأمَلِ ذَاتِهَا، كَانَ عَلَى كُلِّ طِفْلٍ فِي المُخَيَّمِ أَنْ يَنْتَظِرَ عَشَرَةَ أيَّامٍ لِيَأكُلَ خُبْزاً.» (المصدر نفسه: 14) تجدر الإشارة إلى أنه عندما أدرك أبو العبد أن الصفقة أكبر من مجرد سرقة بضعة أكياس من الدقيق، شعر باشمئزاز من التعامل مع هذا الرجل، كما تذكر أن جميع أطفال المخيم كانوا ينتظرون عشرة أيام للحصول على الخبز.
على الرغم من أن الظروف التي يعيشها أبو العبد وعائلته تدل على نقص في الإحساس بالحرية وتهدد بشدة تقدير أبي العبد لذاته وتقلل من قيمته الذاتية، إذ أن «عدم إشباع هذه الحاجة يؤدي إلى مشاعر مثل الدونية، والعجز، واليأس.» (ماسلو، 1993م ب: 82)، إلا أنه، مثل أبي سمير، يتمتع بحرية الاختيار وتحديد مواقفه وأفعاله. في الواقع، على الرغم من الضغوط الخارجية التي تدفعه نحو السرقة، فإن شعور الاشمئزاز الذي يكنه أبو العبد تجاه التعامل مع الرجل الأمريكي يدل على حريته في الاختيار، ومقاومته للضغوط الخارجية، والتزامه بقيمه الأخلاقية الداخلية. يمكن القول إن حديث أبي العبد عن خيبة أمل جميع سكان المخيم وانتظار الأطفال للخبز، يشير إلى اختلاف وجهة نظره عن أبي سمير. فبينما يواجه الاثنان ظروفًا متشابهة، يفضل أبو العبد المصالح الجماعية والقيم الأخلاقية على المصلحة الشخصية. في المقابل، يفضل أبو سمير مصلحته الخاصة على حقوق الآخرين. ورغم أن وصف شخصية أبي سمير بـ"المضادة للمجتمع26" يتطلب معلومات إضافية، إلا أنه نظراً لوجود علامات من هذا الاضطراب، مثل تجاهل حقوق الآخرين لتحقيق مصالح شخصية (غنجي، 2013م: 232)، يبدو أن أبا سمير يمتلك شخصية مضادة للمجتمع، أو على الأقل لديه قابلية للإصابة بهذا الاضطراب.
حاجة تحقيق الذات
يُعدّ تحقيق الذات أسمى مستويات الحاجات الإنسانية، ويتحقق عندما يتمكّن الفرد من إبراز كامل إمكاناته الكامنة والوصول بها إلى أقصى مستوياتها. لكن، حتى مع إشباع حاجات التقدير، لا يصل الأفراد بالضرورة إلى مرحلة تحقيق الذات. يؤمن ماسلو بأن الذين يبلغون هذه المرحلة هم فقط من يعطون أهمية قصوى للحقائق الأبدية27 التي أسماها "قيم الکینونة28" وبخلاف ذلك، حتى لو تم تلبية الحاجات الأساسية للفرد، فلن يحدث تحقيق الذات. تُعتبر هذه القيم الوجودية مؤشرات على الصحة النفسية، وهي تتناقض مع "حاجات النقص" التي تُحفّز الأفراد غير المحققين لذواتهم. وقد حدّد ماسلو أربع عشرة قيمة من قيم الكينونة، وأسماها "الحاجات العليا29" ليُشير إلى كونها مستوى أعلى من الحاجات. وهو يعتقد أن الحرمان من هذه القيم يؤدي إلى "الميتاباثولوجيا30" أو غياب فلسفة حياة ذات معنى. (فيست وآخرون، 2022م: 393-403) وتُعرض قيم الأفراد المحققين لذواتهم في الشكل (2):
صورة (2). قيم "الكينونة" لماسلو: جوهرة بخصائص متعددة (المصدر: فيست وفيست، 2005م: 603)
في هذا المجال، ميّز أبراهام ماسلو الأفراد المحققين لذواتهم عن غيرهم من خلال تقديم مجموعة من الخصائص لتوضيح مفهوم تحقيق الذات. وتشمل هذه الخصائص: إدراك أفضل للواقع والتعامل معه، مقاومة التماهي الثقافي، قبول الذات والآخرين، العفوية والبساطة والطبيعية، الحاجة إلى الخلوة، الإبداع والابتكار، التمييز بين الوسيلة والغاية، والتوجه نحو حل المشكلات. (ماسلو، 1993م ب: 216-238)
عند تحليل القصة، يتضح للوهلة الأولى أن لا توجد أي سمات للأفراد المحققين لذواتهم في شخصية أبي عبد. ومع ذلك، في خضم الأزمة، تظهر إشارات إلى اهتمامه ببعض "قيم الكينونة". يتجلى هذا الاهتمام في سؤاله المفاجئ لأبي سمير عن مدة تعامله مع الحارس والموظف الأمريكي: «مُنذُ مَتَى وَأَنتَ تَتَعَامَلُ مَعَ هَذَا الحَارِسِ وَذَلِكَ المُوَظَّفِ؟.» (كنفاني، 2013م: 13) يطرح سؤاله في أوج اضطرابه الذهني، ويمكن اعتباره شرارة فضول ورغبة في فهم الحقيقة كبعد من هذه القيم. هذا الفضول، بحد ذاته، هو نوع من الثبات المعرفي في مواجهة الجهل المفروض ورغبة في المعرفة. كما أن رد فعله العنيف بعد اكتشاف سبب نقص الدقيق، والذي أدى إلى قتل أبي سمير، على الرغم من أنه نابع من شعور بالخيانة وتهديد البقاء، يمكن أن يكون تعبيراً عن سعيه العميق للعدالة؛ وهي قيمة أخرى من قيم الباء التي تفعّلت في ذاته مع إدراكه لحقيقة الأمر. هذه اللحظات، وإن كانت قصيرة وفي قلب موقف أزموي، يمكن اعتبارها إمكانية لاهتمامه بالقيم الأسمى. لكن، على الرغم من وجود إشارات ضئيلة في شخصية أبي عبد، فإن انغماسه في غمار المشكلات وتركيزه الحتمي على تلبية الحاجات الأساسية، حال دون توفير بيئة مناسبة لتوجه أبي عبد نحو تحقيق ذاته.
كما يرى ماسلو، «يرتبط تحقيق الذات ارتباطًا وثيقًا ببيئة حياة الأفراد.» (شولتز، 1990م ألف: 92) فبيئة المخيم، المليئة بالحرمان والنزوح وانعدام الأمن، حوّلت كل انتباه وطاقة أبي عبد نحو البقاء وتأمين الحاجات الأساسية. ويعترف ماسلو بأن «أقوى دافع للفرد الذي فقد كل ممتلكاته في الحياة سيكون على الأرجح الحاجات الفسيولوجية، لا شيء آخر.» (ماسلو، 1993م ب: 71) في القصة المذكورة أيضاً، تنحصر مخاوف أبي عبد بوضوح في المستويين الأولين من هرم الحاجات: «كَمْ يودُّ لَوْ أَنَّهُ يَنْتَشِلُ عبدالرحمن مِنْ هُزَالِهِ وَخَوْفِهِ.» (كنفاني، 2013م: 13) و«كَانَ لَا يَزَالُ رَاغِباً فِي أَنْ يَرَاهُ يَبْتَسِمُ لِقَمِيصٍ جَدِيدٍ.» (المصدر نفسه: 15)
يرغب أبو عبد في إنقاذ ابنه من الخوف، وحتى اللحظة الأخيرة، يتمنى أن يرى ابتسامة ابنه بسبب حصوله على قميص جديد. في بيئة المخيم القمعية، حيث يخيّم الفشل والحرمان، وتتحول رغبات بسيطة مثل امتلاك قميص جديد وتأمين الأمان إلى أهداف كبيرة وبعيدة المنال، يتأجل الاهتمام بالحاجات والرغبات الأسمى في هرم ماسلو ويُنسى، وذلك لأن المساحة اللازمة لظهور وتنمية إمكانات تحقيق الذات تُسلب من الأفراد. في مثل هذه الظروف، لا يتجلى صمود أبي عبد في سبيل تحقيق الذات بالمعنى الذي قصده ماسلو، بل يتجلى في سبيل الحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية والبقاء.
تحليل عدم تحقيق الذات لشخصية أبو عبد
في خطاب المقاومة وأجوائها، وبسبب الظروف السائدة، غالباً ما يتركز اهتمام الأفراد على المعارك الخارجية والأهداف الجماعية الكبرى، بدلاً من التركيز على النمو والتطور الفردي (تحقيق الذات). في مثل هذا السياق، تتقدم الذات الجماعية31 التي تشمل الهوية المشتركة، والانتماءات الجماعية، والقيم الجمعية، على الذات الفردية32 التي تضم الرغبات والتطلعات والإمكانات الشخصية. بعبارة أخرى، توضع الفردية في خدمة الجماعة؛ ولذلك، تتأجل رغبات الفرد وحتى أحلامه أو تضحى بها في سبيل تحقيق الأهداف التي تؤكد عليها المقاومة. بناءً عليه، يمكن القول إن أجواء المقاومة، كعامل خارجي، قد تكون عائقا ًأساسياً أمام معرفة الذات وتحقيق الحاجات الإنسانية السامية. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار مقاومة الفرد الشخصية أيضاً عائقاً داخلياً يحول دون تحقيقه لذاته.
شخصية أبو عبد، كرمز للشعب الفلسطيني المظلوم والمتضرر من الحرب، تواجه مقاومة خارجية (الظروف التي يفرضها الكيان الصهيوني) ومقاومة شخصية (سعي الفرد لرفع القيود المفروضة). إن عجز أبي عبد عن تأمين حاجاته الفسيولوجية والأمنية، وقلة اهتمامه بالحاجات العاطفية، ونسيانه للحاجات التي تقع في قمة هرم أبراهام ماسلو، هو نتيجة للظروف التي هيأها له المجتمع وأجواء المقاومة. فوفقاً لمعتقد ماسلو: «السبب الرئيسي في أن عدداً قليلاً من الأفراد يستطيعون تحقيق إمكاناتهم الكامنة هو المجتمع الذي لا يستطيع توفير الإمكانيات اللازمة في هذا المجال للأفراد.» (راس، 2003م: 133)
الظروف التي وُجد فيها أبو عبد، لا باختياره بل بالإجبار، فرضت عليه أثمان باهظة؛ تكاليف أبعدته عن مسار تحقيقه لذاته ووضعت خطاً أحمر على إمكانياته في تحقيقها. لذلك، لا يمكن عزو عدم تحقيق أبي عبد لذاته إلى قصور فردي فيه فحسب، بل إن عدم تحقيق الذات هذا هو ثمرة هياكل اجتماعية وسياسية معيبة يمكن أن تلحق بالمجتمع أضراراً لا يمكن إصلاحها على المدى الطويل، لأن تدمير القدرات الفردية يعني تدمير رأس المال البشري وصناع المستقبل المبتكرين الذين يدفعون عجلة تقدم المجتمع على مختلف المستويات.
النتيجة
أظهرت نتائج هذا البحث ما يلي:
فيما يتعلق بالسؤال الأول، يمكن القول إن مقاومة أبي عبد في المواقف المختلفة من القصة لا تمثل تمرداً نشطاً ضد بنية النظام السائد. لقد لجأ بشكل أساسي إلى المقاومة السلبية والداخلية لمواجهة الدوافع الخارجية والضغوط البيئية. ومع ذلك، لا تتغير طبيعة مقاومته وتتخذ طابعاً عنيفاً إلا عندما تشتعل شرارات القيم النبيلة مثل الحقيقة والعدالة في داخله. عند هذه النقطة، تتخذ مقاومته ضد الاستغلال طابعاً ثورياً، وتتجلّى في قتل أبي سمير. يعبر هذا التحول عن أن تغيير نمط مقاومة أبي عبد يخدم المصلحة الجماعية.
أما بخصوص السؤال الثاني، فيمكن القول إن مقاومة شخصية أبي عبد لعدم تحقق أي مستوى من مستويات هرم ماسلو للحاجات قد أثرت على سلوكياته وعلاقاته وقراراته. فعلى مستوى السلوكيات، أدت مقاومة أبي عبد لعدم تلبية حاجات النقص، خاصة الحاجات الفسيولوجية والأمان، بهدف قمع حقائق الحياة غير السارة، إلى استخدام آليات دفاعية مثل التجنب والکبت. كما أن مقاومته الأخلاقية في مواجهة الظلم أدت إلى استخدام آلية الدفاع عن الإزاحة، وخير مثال على ذلك قتل أبي سمير.
ولكن على مستوى العلاقات، فإن انشغال أبي عبد بالطعام والعمل منعه من مقاومة تفكك العلاقات من خلال الحوار البناء، ولهذا، أدى عدم المقاومة هذا إلى فتور العلاقات الأسرية وتضاؤلها. يمكن ملاحظة التأثير الأكبر لمقاومة أبي عبد على مستوى القرارات، فبسبب الضغوط والمحفزات الخارجية، ينهض كل جزء من شخصيته كمقاومة استراتيجية ذهنية، وفي النهاية، يؤدي ثبات جزء من ذاته إلى رفضه للسرقة كجزء من دوافع الـ"هو".
المصادر والمراجع
بصیري، محمد صادق ونسرین فلاح. (۲۰۱۴م). «مبانی نظری ادبیات مقاومت در آثار غسّان کنفانی». نشریه ادبیات پایداری. السنة الـ6. العدد ۱۰. صص ۹۰_ ۶۵
ترابي، ضياءالدين. (٢٠١١م). آشنایی با ادبیات مقاومت جهان. طهران: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
الجیوسي، سلمى الخضراء. (١٩٩٧م). موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر. انطولوجيا. بيروت: منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
حساویان، میلاد. (۲۰۲۲م). ترجمه و شرح رمان "القمیص المسروق" از عربی به فارسی اثر غسّان کنفانی. رسالة ماجستير. رفسنجان: جامعة ولیعصر.
خضیري نيسي، هنا. (٢٠٢٣م). جلوههای ادبیات پایداری در مجموعه داستان کوتاه الرجال والبنادق اثر غسّان کنفانی. رسالة ماجستير. أهواز: جامعة الشهید چمران.
راس، آلن اُ. (۲۰۰۳م). روانشناسی شخصیت (نظریهها و فرآیندها). ترجمه سیاوش جمالفر. طهران: انتشارات روان.
زینیوند، تورج و سمیه صولتي. (۲۰۱۷م). «نشانهشناسی اجتماعی داستان کوتاه "القمیص المسروق" کنفانی با تکیه بر سازههای گفتمانی هلیدی». مجله زبان و ادبیات عربی. السنة الـ9. العدد ۱۶. صص ۱۶۰_ ۱۲۷
سيّد عبد الرحمن، محمد. (١٩٩٨م). نظريات الشخصية. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
شولتز، دوان. (۱۹۹۰م الف). روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم. ترجمه گیتی خوشدل. ط 5. طهران: انتشارات نو.
شولتز، دوان. (۱۹۹۰م ب). نظریههای شخصیت. ترجمه یوسف کریمی وزملاؤه. ط 4. طهران: انتشارات ارسباران.
شولتز، دوان. (۲۰۰۶م). روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم. ترجمه گیتی خوشدل. ط 13. طهران: انتشارات پیکان.
صالح بك، مجيد وهايده عجرش. (٢٠٢٥م). «شخصيت پردازی در رمان "ملک الهند" جبور دویهی بر پایه نظریه آبراهام مزلو». پژوهشنامه ادبیات داستانی.
صالحي، بیمان وكلثوم باقري. (٢٠٢٢م). «تحلیل شخصیت اصلی رمان ایام معه براساس نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو». مجله ادب عربی. السنة الـ13. العدد الـ4. صص ۱۰۷_ ۸۷
عموری، نعیم وسیّد حسن نجاتی. (۲۰۱۹م). «تحلیل مؤلفههای ادبیات پایداری در رمان رجال فى الشمس اثر غسّان کنفانی». مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب. السنة الـ1. العدد ۱. صص ۷۷_ ۵۹
غنجي، مهدي. (٢٠١٣م). آسیبشناسی روانی براساس DSM-5. طهران: انتشارات ساوالان.
فرانك، برونو. (۱۹۹۱م). فرهنگ توصیفی روانشناسی. ترجمه مهشید یاسایی و فرزانه طاهری. طهران: انتشارات طرح نو.
فروید، آنا. (۲۰۱۸م). خود و مکانیسمهای دفاع روانی. ترجمه فرزام حبیبی اصفهانی. ط ۱. طهران: انتشارات شبگون.
فيست، جس؛ فيست، جريجوري جي. (٢٠٠٥م). نظریههای شخصیت. ترجمه یحیی سیّد محمدی. طهران: انتشارات روان.
فیست، جریجوري جي وآخرون. (٢٠٢٢م). نظريههای شخصیت. ترجمه یحیی سیّد محمدی. طهران: انتشارات روان.
قنجعلي، عباس وفائزه ایزي وسيّد مهدي نوري كيذقاني. (٢٠٢٤م). «بررسی شخصیت اصلی رمان "إختفاء السيد لاأحد" برمبناى نظریه آبراهام مزلو». مجله نقد ادب معاصر عربی.
كارفر، جارلز اس؛ شیر، مایکل اف. (٢٠٠٨م). نظريههای شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. ط 2. مشهد: شرکت بهنشر.
كنفاني، غسّان. (٢٠١٣م). القميص المسروق. قبرص: منشورات الرمال.
ماسلو، ابراهام. (١٩٨٨م). روانشناسی شخصیت سالم. ترجمه شیوا رویگریان. طهران: انتشارات هدف.
ماسلو، ابراهام. (١٩٩٣م الف). افقهای والاتر فطرت انسان. ترجمه احمد رضوانی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
ماسلو، ابراهام. (١٩٩٣م ب). انگیزش و شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. ط 3. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
هريدي، عادل محمد. (٢٠١١م). نظريات الشخصية. ط ٢. القاهرة: دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع.
رابطۀ پایداری شخصیت "ابوعبد" در داستان "القمیص المسروق" اثر غسّان کنفانی با محورهای نظریۀ سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو
چکیده
ادبیات مقاومت، رنج انسانهای درگیر با شرایط دشوار تحمیلی را از طریق پردهبرداری از فشارهای اجتماعی و سیاسی به تصویر میکشد. این رویکرد، به روشن شدن پیوندهای ادبیات، جامعهشناسی و روانشناسی و نیز شکلگیری نقد روانشناختی انجامیدهاست. در این حوزه، آبراهام مازلو نظریۀ سلسله مراتب نیازهای خود را ارائه دادهاست. این نظریه نشان میدهد که چگونه نیازهای انسان، بر کنشها و روابط او تأثير میگذارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی برآن است تا به بررسی ثبات یا تغییر الگوی مقاومتی شخصیت ابوعبد در داستان "القمیص المسروق" اثر غسّان کنفانی، نویسنده فلسطینی بپردازد و چگونگی تأثير مقاومت ابوعبد در پرتو سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو، بر رفتارها، روابط و تصمیمگیریهای او را بررسی نماید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقاومت ابوعبد در ابتدا منفعلانه و درونی است، اما جوشش عدالتخواهی در وجودش، آن را به مقاومتی پرخاشگرانه مبدّل میسازد. علاوه بر این، مقاومت او در برابر ناکامی نیازهای اساسی، به فعال شدن سازوکارهای دفاعی اجتناب، سرکوب و جابجایی در او منجر شدهاست. با این حال، دغدغۀ معاش مانع از مقاومت در برابر سردی روابط او گشتهاست، اما در سطح تصمیمگیریها، مقاومت او را از پیروی وسوسههای نهاد و تن دادن به دزدی بازداشتهاست.
کلمات کلیدی: ادبیات پایداری، غسّان کنفانی، القمیص المسروق، آبراهام مازلو، نظريه سلسله مراتب نیازها.
The relationship between the stability of Abu Abd's personality in Ghassan Kanafani's story 'The Stolen Shirt' and the theoretical frameworks of Abraham Maslow's Hierarchy of Needs
Abstract
Resistance literature portrays the suffering of individuals caught in challenging imposed conditions by unveiling social and political pressures. This approach has illuminated the connections between literature, sociology, and psychology, leading to the development of psychological criticism. Within this field, Abraham Maslow introduced his Hierarchy of Needs theory, which demonstrates how human needs influence actions and relationships. The current research employs a descriptive-analytical method to investigate the stability or change in the resistance pattern of the character Abu Abd in Ghassan Kanafani's story "The Stolen Shirt," a work by the Palestinian author. It also examines how Abu Abd's resistance, viewed through Maslow's Hierarchy of Needs, impacts his behaviors, relationships, and decision-making. The findings indicate that Abu Abd's resistance is initially passive and internal, but a burgeoning sense of justice within him transforms it into aggressive resistance. Furthermore, his resistance to the frustration of basic needs has activated defensive mechanisms of avoidance, repression, and displacement. However, concerns about livelihood have prevented him from resisting the coldness of his relationships. Yet, at the level of decision-making, his resistance has deterred him from succumbing to id-driven temptations and engaging in theft.
Keywords: Resistance Literature, Ghassan Kanafani, The Stolen Shirt, Abraham Maslow, Hierarchy of Needs Theory.
[1] Resistance literature
[2] Sigmund Freud
[3] Abraham Harold Maslow
[4] Hierarshy of Human Needs
[5] Michael Halliday
[6] Behavioral Psychology
[7] Humanism
[8] Kurt Goldstein
[9] Physiological needs
[10] Safety needs
[11] Belonging and love needs
[12] Self-esteem needs
[13] Self-actualization needs
[14] Aesthetic Needs
[15] Cognitive Needs
[16] Neurotic Needs
[17] Avoidance Defense Mechanism
[18] Repression Defense Mechanism
[19] Id
[20] Ego
[21] خلال عشرينيات القرن الماضي، قسّم سيغموند فرويد بنية العقل إلى ثلاثة مجالات وظيفية: الهي، والأنا، والأنا العليا. هذه المجالات الوظيفية هي مجرد تراكيب افتراضية ليس لها وجود مكاني. (فيست وفيست، 2005م: 40)
[22] Slip of the Tongue
[23] Displacement Defense Mechanism
[24] Expressive behavior
[25] Viktor Frankle
[26] Antisocial personality
[27] Eternal verities
[28] B-values
[29] Meta needs
[30] Meta pathology
[31] Collective self
[32] Individual self